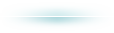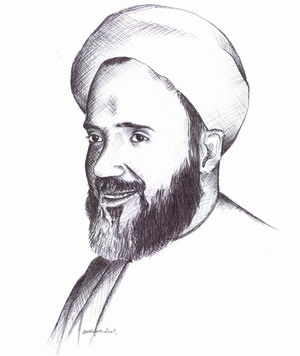هل تخرج الخطابة النسائية في المجتمع الشيعي من نفقها المظلم ؟
هل تخرج الخطابة النسائية في المجتمع الشيعي من نفقها المظلم؟
في خضم الأجواء الحسينية لعاشوراء الإمام الحسين  وما تواكبها من ممارسات وطقوس دينية متعددة، تطفو على السطح أجنده تفرض وجودها كأولويات تحظى باهتمامات المجتمع، وهذا ماشجعني على كتابة المقال الأول تحت عنوان: «خطباء المنبر الحسيني بين فكر تقليدي وحداثة تفرضها تحديات العصر»، وكان ذلك تحت عنونة الواقع الذي يعيشه المنبر الحسيني والتحديات التي يواجهها في الوقت الراهن سواء على مستوى مكوناته وحيثياته أو على مستوى المسئولية الملقاة على عاتق الخطباء من منطلق المؤثر والمتأثر وماينتج عنهما من عملية تأثير مباشر وغير مباشر على نطاق المكونات الاجتماعية والدينية والثقافية لتلك المجتمعات، وقد لاقى هذا المقال استحسان الكثيرين خاصة أنه يتواكب مع دعوة العقلاء في معظم المجتمعات الشيعية لتقنين وتحديث المنبر الإعلامي الأول في الطائفة الشيعية والذي يعبر عن عقيدتها ومنهجيتها عما عاشته وتعيشه الأمة الإسلامية برمتها.
وما تواكبها من ممارسات وطقوس دينية متعددة، تطفو على السطح أجنده تفرض وجودها كأولويات تحظى باهتمامات المجتمع، وهذا ماشجعني على كتابة المقال الأول تحت عنوان: «خطباء المنبر الحسيني بين فكر تقليدي وحداثة تفرضها تحديات العصر»، وكان ذلك تحت عنونة الواقع الذي يعيشه المنبر الحسيني والتحديات التي يواجهها في الوقت الراهن سواء على مستوى مكوناته وحيثياته أو على مستوى المسئولية الملقاة على عاتق الخطباء من منطلق المؤثر والمتأثر وماينتج عنهما من عملية تأثير مباشر وغير مباشر على نطاق المكونات الاجتماعية والدينية والثقافية لتلك المجتمعات، وقد لاقى هذا المقال استحسان الكثيرين خاصة أنه يتواكب مع دعوة العقلاء في معظم المجتمعات الشيعية لتقنين وتحديث المنبر الإعلامي الأول في الطائفة الشيعية والذي يعبر عن عقيدتها ومنهجيتها عما عاشته وتعيشه الأمة الإسلامية برمتها.
وحتى تكتمل الصورة الكاملة لهذا الطرح كان لابد من التطرق للشق الثاني والمتعلق بالجانب النسائي والمعروف بالخطابة النسائية في المجتمعات الشيعية والذي لايقل أهمية عن الشق الأول، بالرغم من قناعتي الشخصية أن مفهومها لم يرتق إلى المستوى المطلوب والمؤمل لدور المرشدة والمبلغة ولكننا نستخدمه مجازاً لإيصال المعنى والفكرة لقرائنا الكرام.
وأتفق مع الأصوات التي ترى أن المنبر الوعظي لدى الفئة الرجالية يستهدف جميع شرائح المجتمع بكل أطيافه ومكوناته بما فيهم العنصر النسائي، والذي سعى لإيصال صوته لكل فرد من أفراد المجتمع رجل كان أو امرأة عبر تجمعات نسائية مستقلة تستطيع من خلالها المرأة الاستماع للخطابة الرجالية أو عبر تقنيات تستخدم البث المباشر عبر شبكة تلفزيونية مغلقة أو الانترنت.
وفي تصوري أن الخطابة النسائية في المجتمع الشيعي مرت ولازلت تمر بحالة من الجمود الفكري المطروح والمركز على مصيبة أهل البيت  وهي أسوء حالاً من مثيلاتها عند الرجال، إذ تعتمد الخطيبة أو ماتعرف في الأوساط الاجتماعية «بالملاية» على الطريقة البدائية والتي جعلت الخطابة النسوية متخلفة وبعيدة عن الهدف المنشود لها وكانت بحاجة إلى نهضة قوية تخرجها من نفقها المظلم. وانتهجت الخطابة النسائية في مجتمعاتنا خطين أولهما: الخطابة الحسينية ذات الطابع الحسيني البحت، وأما الخط الثاني: فمظهر احتفائي بالمناسبات الدينية والاجتماعية السعيدة والمعتمدة على حفظ قصائد المدح والثناء.
وهي أسوء حالاً من مثيلاتها عند الرجال، إذ تعتمد الخطيبة أو ماتعرف في الأوساط الاجتماعية «بالملاية» على الطريقة البدائية والتي جعلت الخطابة النسوية متخلفة وبعيدة عن الهدف المنشود لها وكانت بحاجة إلى نهضة قوية تخرجها من نفقها المظلم. وانتهجت الخطابة النسائية في مجتمعاتنا خطين أولهما: الخطابة الحسينية ذات الطابع الحسيني البحت، وأما الخط الثاني: فمظهر احتفائي بالمناسبات الدينية والاجتماعية السعيدة والمعتمدة على حفظ قصائد المدح والثناء.
وتفتقد هذه المناسبات بشقيها إلى حالة من التثقيف والتوجيه ولا يتحسس منها أي طابع ينم عن معالجة جدية للتحديات والمشاكل الأسرية والاجتماعية السائدة، أو محاولة لتنمية فكر المرأة وثقافتها وتبصيرها بالمخاطر المحدقة بها وبأسرتها، وهذا ماتؤكده التقارير والاستبانات التي تتفق وتؤيد ماذهبنا إليه، وينسجم مع الأصوات التي تعالت في السنوات الماضية هنا وهناك من علماء ومثقفين لتغير هذا الحال المتردي الذي تعيشه الشريحة الكبرى من الخطيبات واللاتي تعرفن «بالملايات».
ولست هنا ضد أصل الفكرة بقدر أنني أنتقد الكيفية والمنهج التي يتعاطى بها المجتمع النسائي مع المناسبات الدينية المتعلقة بأفراح وأحزان أهل البيت  وما يعتريها من تجاوزات سلبية تسيء إلى حد ما إلى مدرسة أهل البيت
وما يعتريها من تجاوزات سلبية تسيء إلى حد ما إلى مدرسة أهل البيت  والتي من أجل مبادئهم وعقيدتهم نشأت هذه المناسبات.
والتي من أجل مبادئهم وعقيدتهم نشأت هذه المناسبات.
ونذكر مثالاً وليس للحصر وجود ظاهرة التدخين والمعروفة «بالقدو» في بعض مناطقنا حيث تصر بعض «الملايات» على بقائها لاسيما في مناسبات الأحزان، وهي ممارسة سلبية وظاهرة غير صحية سواء من ناحية سلوكية أو جسمية وما تنتجه من تقليد أعمى لهن بين الفتيات، ولكن بفضل الوعي المتنامي في أوساط الشابات بدأت هذه الظاهرة تنحصر رويداً رويداً، وذلك شجع على وأدها حتى تصبح المجالس الحسينية مدعاة لكل حسن ونبذ كل مظهر يسيء لها، وهذا مثال مقتبس وليس المقصود حصر السلبية في هذا الجانب فقط.
وقد يتصور البعض أن الخطابة النسائية ليست ذات تأثير قوي كمثيلاتها عند الرجال، ولكن النظرة الواقعية أثبتت أن الخطابة النسائية بشتى أنواعها ذات تأثير جذري ومباشر على المجتمع النسائي وهذا يبدو جلياً في تعاطي الأوساط المتعددة في دول العالم معها سواء من ناحية المنهج المستخدم أو الإفرازات الايجابية والسلبية التي تنتجها هذه الخطابة في السلوكيات والعادات والأفكار السائدة في المجتمع النسائي، وهي نظرة عامة وليست قاصرة على مجتمع أو فئة أو معتمدة على نوعية الخطاب بل تشمل جميع الأطياف واللغات والأجناس في المجتمعات البشرية.
وبنظرة فاحصة لاستقراء الخطابة النسائية في المجتمعات الشيعية نخلص بنتيجة أن لها تأثيراً مباشراً على الشريحة النسائية وذلك لعدة أسباب أولها: التأثير المباشر والقوي للخطابة في مثيلاتها من الجنس وهذا عائد إلى وجود تفاوت في التأثير العاطفي والنفسي والسيكولوجي بين البشر والذي يعتمد على قاعدتين هما: الملقي والمتلقي والذي يعتمد بدوره على عوامل أهمها: مدى الأفق العاطفي والوجداني وتوافق نوعية الجنس البشري والعمر والمكان والقرب والبعد وعوامل أخرى حددها علماء النفس فيما يعرف بعملية التأثير والمؤثر في نظريات علم النفس الإنساني، وكون الملقي والمتلقي من صنف واحد فتكون النساء أكثر انسجاماً وفهماً وقبولاً عند مثيلاتها من جنسها وبالتالي تكون الأرضية ممهدة في قبولهن بما يطرح من أفكار ومعطيات نادت بها «الملاية» سواء في منحى الإيجابية أو السلبية. أما السبب الثاني فهو: الخصوصية التي تتمتع بها مناسبات أهل البيت  بمجتمعاتنا وهذا متعلق بالموروث الديني والعقدي لمجتمعاتنا، والذي حرص على نقل هذا المفهوم لأجيال متتالية وخاصة في المآتم الحسينية التي تعقد في الحسينيات والمنازل.
بمجتمعاتنا وهذا متعلق بالموروث الديني والعقدي لمجتمعاتنا، والذي حرص على نقل هذا المفهوم لأجيال متتالية وخاصة في المآتم الحسينية التي تعقد في الحسينيات والمنازل.
أما السبب الثالث فهو: وجود مفارقة واضحة بين المجالس النسائية عن مثيلاتها لدى الرجال مما يجعلها أكثر جذباً وقابلية لديهن سواء بالكيفية وقدرة المرأة في التعبير عن شعورها داخل المجلس النسائي والمتعلق بالحالة الدينية السائدة في مجتمعاتنا، لاسيما أن ثمة مواضيع ذات خصوصية نسائية وأنثوية بحتة لايمكن مناقشتها وطرحها في محفل عام لأننا في مجتمع يحترم هذه الخصوصية ويضع حدوداً للأدب واللباقة فيما يطرح ويناقش، وخاصة فيما يتعلق بفقه الجنس والمرأة.
أما السبب الأخير فهو: إمكانية حصر الخطاب النسوي في الإطار الأنثوي لتوجيهها سلوكياً واجتماعياً وطرح كل مايتعلق بالحياة الأسرية والزوجية كونها المستهدف الأول والأخير من هذا الخطاب.
بينما نجد في المقابل أن الخطابة الرجالية تفرض على الملقي أو الخطيب حالة من التنوع في الفكر المطروح سواء في نوعية المادة المطروحة أو الشريحة المستهدفة فيشمل الخطاب أطياف المجتمع بمختلف أنواعه وطبقاته، وهناك عدة أسباب أخرى ستظهر مع السياق من خلال تتبعنا لهذا المقال.
وبنظرة فاحصة داخل المجتمع في الوقت الراهن نخرج بنتيجة مفادها أن الخطابة النسائية انتشرت بشكل كبير وواسع بين الفئة النسائية والمعروف بالسلك الحسيني، ويتركز تحديداً بين الفتيات منهن والذي كان مقتصراً إلى عهد قريب على كبار السن فكثر بمجتمعنا مايعرفن «بالملايات».
ويعود إقبال الفتيات للانخراط بهذا المحفل الديني إلى تجاذبات وأسباب متفاوتة وسار في اتجاهين متناقضين أولهما: المنحى السلبي الذي أخذته الخطابة النسائية وهو الطامة الكبرى التي أشعر بخطرها عبر انتهاج فئة كبيرة من النساء الخطابة كمظلة لنيل هدفها الضيق والمحدود والذي لايتعدى أهداف شخصية وتنافسية ثانوية تصل إلى حد غير مقبول لا على مستوى ديني أو اجتماعي، فأنزلت هذا الخطاب إلى مستوى حضيض، وكان لابد من تسليط الضوء في أسباب انحداره والطرق الكفيلة لتغيير الحال المأساوي الذي آلت إليه الخطابة النسائية سواء من ناحية الأسلوب أو المنهجية عند الفئة الأغلب لـ «الملايات».
وعند البحث عن المغريات التي شجعت هذه الشريحة في التشبث بسلك الخطابة نجدها منحصرة في أمرين أولها: السعي للحصول على مكتسب مادي أو معنوي من المجتمع، وثانيهما: وجود حالة من التنافس الغير شريف والمبني على صفات الحسد والبغض والغيرة داخل المجتمع النسائي، وهنالك أسباب ثانوية مكملة للسببين الرئيسين ومنها: حالة من الفراغ، وعدم وعيهن بمستوى المسئولية التي تقع على المتصديات للعمل الاجتماعي والثقافي.
فنشأت شريحة كبرى من «الملايات» واللاتي تفتقدن لأقل مقومات الخطيبة والمرشدة الناجحة، وتفاقمت هذه الظاهرة لتأخذ منحى أخطر على مجتمعاتنا بظهور أفكار وممارسات سيئة وهي نتاج للحالة الخاطئة التي انتهجتها هذه الفئة سواء في الأسلوب والممارسة، والذي أنعكس سلباً على المجتمع النسائي وفرضت واقع مغاير أوجدته هذه الممارسات في كثير من الأحيان.
وحتى نسلط الضوء على لب المشكلة يجب أن نتعرف على الظواهر والإشكالات التي تفرزها هذه المناسبات والتي تسيء بشكل مباشر وغير مباشر على المجتمعات في عدة نقاط منها:
النقطة الأولى: أن أغلب الفئة النسوية التي انتهجت السلك الديني فئة أشبه بالمتطفلات واللاتي تفتقدن لأقل مستوى علمي وثقافي وديني، وهي فئة ليست بالقليلة واللاتي يقتصرن على نطق الكلمات وحفظ المراثي والقصائد وتوظيف المجلس العزائي للمراثي والبكاء، وحفظ الأهازيج والأرجوزات، واعتمادهن على ترديد الكلمات من كتاب تحمله بين يديها!!، بالرغم أننا لسنا ضد هذا الأسلوب كون بعض المناسبات تعتمد على أطوار وأشكال عديدة تستوجب وجود الكتاب لدى الخطيبة.
ولكننا في باب القول: أن الكثيرات منهن تفتقدن لأقل المقومات الشخصية التي تؤهل للعب هذا الدور وبالتالي عدم قدرتهن على نشر الفكر أو النصيحة ولاتعي حساسية وأهمية الدور الذي تلعبه وصدق من قال: فاقد الشيء لايعطيه، ومن هذا المنطلق نتساءل: أن هذه الخطيبة التي لا تستطيع إيصال ابسط المفردات إلا عن طريق كتاب فهل بإمكانها أن توصل فكر تربوي لمستمعيها عبر كتاب أو بدونه؟.
وفي المجمل نجد أن معظم «الملايات» تعتمد على قراءة مباشرة من كتب وهي حقيقة مسلم بها في الوسط النسائي، وهي أشبه تماماً بالمعلم الذي يعتمد على أسلوب التلقين في ممارسة مهنة التعليم، والذي يفقدها حيوية الدور الريادي داخل المجتمع، وهذا هو السبب الذي شجع الكثيرات منهن للانخراط والتلبس بلباس الخطيبة أو المرشدة كون المسألة لاتحتاج منها إلا لمعرفة طور حسيني وقصائد مدح وأهازيج من كتاب تحمله بين يديها!!.
وهو في نفس الوقت السبب الرئيس في وصول الخطابة النسائية لهذا المستوى المتدني من حيث المستوى والأسلوب والمنهج والمادة المطروحة مما عكس سلبيات عديدة داخل المجتمع النسائي.
النقطة الثانية: أن أغلب مايتسمون «بالملايات» كانوا ولازالوا يهدفون إلى المردود المادي والذي تدره عليهم المناسبات الدينية وخاصة مناسبات أفراح أهل البيت  ، ويبدو هذا الهدف واضحاً في المناسبات الاجتماعية كمناسبة عقد القران والخطبة والزواج ومايعرف «بالفاتحة» باشتراطهن مبالغ باهظة ومكلفة على طبقة كبيرة من شرائح المجتمع واللاتي لا يراعين فيها غني أو فقير، ومن المفارقات العجيبة في الأمر أن الخطيب الذي يخطب بفاتحة رجالية لا ينال نصف الأجر الذي تتعاطاه «الملاية» في نفس المناسبة!! والأعجب من ذلك كله أن إحياء ليلة عقد أو زواج تضاهي أجرة خطيبة في عشرة أيام خطابة!!!، والذي سيتضح صورته في النقطة الرابعة.
، ويبدو هذا الهدف واضحاً في المناسبات الاجتماعية كمناسبة عقد القران والخطبة والزواج ومايعرف «بالفاتحة» باشتراطهن مبالغ باهظة ومكلفة على طبقة كبيرة من شرائح المجتمع واللاتي لا يراعين فيها غني أو فقير، ومن المفارقات العجيبة في الأمر أن الخطيب الذي يخطب بفاتحة رجالية لا ينال نصف الأجر الذي تتعاطاه «الملاية» في نفس المناسبة!! والأعجب من ذلك كله أن إحياء ليلة عقد أو زواج تضاهي أجرة خطيبة في عشرة أيام خطابة!!!، والذي سيتضح صورته في النقطة الرابعة.
ومن السلبيات التي تنتهجها بعض «الملايات» في مناسبات الأحزان الاجتماعية «الفاتحة» هو تعمدهن إثارة عواطف وشجون أصحاب المصيبة بشكل مباشر مما ينعكس سلباً على نفسياتهن ويعكس مرة أخرى ضحالة الفكر الواعي والمتحضر عند هؤلاء النسوة، واللاتي كان من المفترض أن ينصب دورهن في تخفيف المصيبة ولملمة الجراح وليس زيادة المأساة على أصحابها وينطبق عليها المثل الشعبي: زاد الطين بله.
النقطة الثالثة: أن معظم النسوة التي سلكوا هذا الطريق لايمتلكون أقل مستوى سقفي من الأخلاق الذي يؤهلها أن تكون قدوة في الإطار الذي تنتمي إليه، والذي أوجد جداراً حاجزاً في إيصال فكرها إلى مستمعيها، كون أن سلوكياتها وأفعالها لاتعبر عما تطرحه وتنادي به، وهي مشكلة تواجه عموم الخطباء والدعاة.
وهناك أسباب أخرى تختص بالمرأة منها: قلة التثقيف الذاتي لدى المجتمع النسائي عند هذه الشريحة، وقلة وانحسار التنوع الفكري بين النساء في هذه المجتمعات، والطبيعة الخاصة للمرأة والتي تتأثر بالمحيط الخارجي بشكل كبير وهذا مانجده جلياً في اهتمام الكثيرات في البحث عن الكماليات من ملبس وزينة وموضات وما إلى ذلك.
وهنا نعرف لب المشكلة الحقيقية «فالملاية» كانت من المفترض أن تكون في موضع المؤثر وليس المتأثر ولكننا نجد أن غالبيتهن تتأثر بالمحيط الخارجي وبخاصة في الجانب السيئ فتتخذه وتروج له بشكل مباشر أو غير مباشر لمستمعيها.
وحتى تكون الصورة أوضح في هذا الجانب نلحظ المفارقات العجيبة وسياسة الكيل بمكيالين، ويبدو واضحاً مع الأقوال التي يتناقلها المجتمع النسائي عن كثير ممن يعرفن باسم «الملايات»، فتجد مناسبات الفرح مناسبات صاخبة لها ولأقاربها بحرصها على لبس الثوب الجميل الذي يعكس بهجتهن بهذه المناسبة، ويشجعن بناتهن وأخواتهن على حضور مثل هذه المناسبات ولبس مظاهر الفرح من ألبسة وزينة وما إلى ذلك مع كل مناسبة سعيدة تمر عليهن، وكأننا في مسابقة ملكة جمال المولد أو السهرة لكي تحظى ابنتها أو قريبتها بنظرة امرأة مدعوة لتكون زوجة لأبنها أو أخيها أو قريبها!!
بالمقابل تجدهن في مناسبات الأحزان يخجلن أن يظهرن بناتهن بمظهر الحزن عبر لبس السواد ونزع كل مظهر من مظاهر الفرح، ولا يبدون أي حرص في تشجيع بناتهن وأقربائهن لحضور هذه المناسبات كما هو الحال في مناسبات الأفراح، وهذا ماجعل كثير من النساء يوجهن الانتقاد اللاذع لمايسمون «بالملايات».
وهذا يدل مرة أخرى على أنها تسعى لمكاسب دنيوية بعيدة كل البعد عن مكاسب أخروية وأنها تلبست بلباس ليست أهلاً له، فالمحب يجب أن يتفاعل مع مناسبة الفرح والحزن بنفس المستوى والوتيرة وإظهار كل مايجسد حقيقة الانتماء الحقيقي لأهل البيت  وهذا مصداق لقول أمير المؤمنين
وهذا مصداق لقول أمير المؤمنين  : إن الله تبارك وتعالى اطّلع إلى الأرض فاختارنا، واختار لنا شيعة ينصروننا، ويفرحون لفرحنا، ويحزنون لحزننا ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا، أولئك منّا وإلينا.
: إن الله تبارك وتعالى اطّلع إلى الأرض فاختارنا، واختار لنا شيعة ينصروننا، ويفرحون لفرحنا، ويحزنون لحزننا ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا، أولئك منّا وإلينا.
النقطة الرابعة: وهي الأخطر في نظري وهي انحراف وظيفة المبلغة أو الخطيبة عن منحنى القيم الدينية والاجتماعية وهي حقيقة مخجلة ولكنها لابد أن تقال. فوظيفة الخطيبة الترويج لكل خلق وسلوك ومنهج يكون له مردود حسن على المجتمع، لكننا نلحظ انحرافها عن الجادة الصحيحة بعد الزخم الكبير في تشجيع الاحتفاء بمناسبات ذكرى مواليد أهل البيت  وتخطاه ليشمل مناسبات العقد والزواج، فلم يقتصر دور «الملاية» على مجالس العزاء والأحزان كون أن مثل هذه المجالس لاتدر عليها مبالغ طائلة كما هو الحال في مناسبات عقد القران والزواج، وهذا مايجعلها تقدم المهم على الأهم من وجهة نظرها، فلمجرد أن يأتيها عرض لمناسبة زواج أو قران ويتضارب وقتها مع مجلس وعظي أو اجتماعي فتقدمه عليه!! بحجة تقديم الأهم على المهم، وهذا في نظري أسوء صور الاستخفاف بالقيم الدينية ويعكس صورتهن الحقيقية للمجتمع.
وتخطاه ليشمل مناسبات العقد والزواج، فلم يقتصر دور «الملاية» على مجالس العزاء والأحزان كون أن مثل هذه المجالس لاتدر عليها مبالغ طائلة كما هو الحال في مناسبات عقد القران والزواج، وهذا مايجعلها تقدم المهم على الأهم من وجهة نظرها، فلمجرد أن يأتيها عرض لمناسبة زواج أو قران ويتضارب وقتها مع مجلس وعظي أو اجتماعي فتقدمه عليه!! بحجة تقديم الأهم على المهم، وهذا في نظري أسوء صور الاستخفاف بالقيم الدينية ويعكس صورتهن الحقيقية للمجتمع.
وفي صورة غير بعيدة عن هذا الكلام كانت مناسبات العقد والزواج مكان لترويج السلوكيات والأفكار الدخيلة على مجتمعاتنا والتي ساعدت بعض «الملايات» على نشرها وتشجيعها، فكان من المفترض أن تكون هذه «الملاية» مدعاة لكل فكر واعٍ ومهذب عبر أهازيج ومواويل تتحدث عن فضل النبي وأهل بيته  ، واحترام القيم الدينية والاجتماعية، ولكن الطامة أن هذه الخطيبة -أن صح التعبير عنها مجازاً تروج لقصص الغرام وأغاني التلفزيون المحرمة شرعاً وتشجع الغناء والطرب ولبس الألبسة الغير محتشمة، واستخدام الآلات الموسيقية المطورة والمحرمة شرعاً، ومايصحبه من سلوك غير محبب كرقص ومرج من بعض النساء، وبالتالي شجع على خروج هذه المناسبات من حالة المألوف اجتماعياً إلى حالة من اللامقبول في بعض الأحيان، والسبب في ذلك هو من قالوا عنها «ملاية»!! ومن باب الإنصاف أن اللوم في المقام الأول موجه إلى من جاء بها وشجعها ودفع أجرتها التي تعادل راتب موظف بالمرتبة الثالثة لمدة شهر بأكمله!!!.
، واحترام القيم الدينية والاجتماعية، ولكن الطامة أن هذه الخطيبة -أن صح التعبير عنها مجازاً تروج لقصص الغرام وأغاني التلفزيون المحرمة شرعاً وتشجع الغناء والطرب ولبس الألبسة الغير محتشمة، واستخدام الآلات الموسيقية المطورة والمحرمة شرعاً، ومايصحبه من سلوك غير محبب كرقص ومرج من بعض النساء، وبالتالي شجع على خروج هذه المناسبات من حالة المألوف اجتماعياً إلى حالة من اللامقبول في بعض الأحيان، والسبب في ذلك هو من قالوا عنها «ملاية»!! ومن باب الإنصاف أن اللوم في المقام الأول موجه إلى من جاء بها وشجعها ودفع أجرتها التي تعادل راتب موظف بالمرتبة الثالثة لمدة شهر بأكمله!!!.
وهذا نتاج عن ضحالة الفكر الذي تحمله هذه «الملاية» والمعتمد على النظرة المادية البحتة فقط، وتعكس صورة مشوهة في تقمصها لشخصية ليست أهل لها، ومن المفارقات المخجلة أن هذه «الملاية» التي تتغنى بالطرب والموسيقى والأغاني أنها وبنفس اللسان تتحدث عن فاطمة الزهراء  وعفافها وأخلاقها ومبادئها وترثي مصائب أهل البيت
وعفافها وأخلاقها ومبادئها وترثي مصائب أهل البيت  ، وهذا أدنى مستوى من الاستخفاف بمبادئ ونهج محمد وأهل بيته
، وهذا أدنى مستوى من الاستخفاف بمبادئ ونهج محمد وأهل بيته  .
.
واجزم أننا في حالة يرثى لها في تعاطي المجتمع مع دور الخطيبة في مناسبات أهل البيت  لأسباب ذكرتها وتتفاوت من امرأة إلى أخرى، فمن الصعب على المصلحين والمثقفين والواعين أن يغيروا واقع اجتماعي جاء عن طريق أفراد كانوا من المفترض أن يكن في موقع المصلحة فأصبحت في موقع المخلة بالقيم الاجتماعية والدينية.
لأسباب ذكرتها وتتفاوت من امرأة إلى أخرى، فمن الصعب على المصلحين والمثقفين والواعين أن يغيروا واقع اجتماعي جاء عن طريق أفراد كانوا من المفترض أن يكن في موقع المصلحة فأصبحت في موقع المخلة بالقيم الاجتماعية والدينية.
ولكي نخرج من هذه القوقعة التي نحن في إطار علاجها يجب أن تتضافر الجهود من الجميع للحيلولة من تفشيها، ولذلك نحن بحاجة إلى وجود حالة من الوعي الاجتماعي لتفعيل وتطوير جانب الخطابة النسائية والقضاء على المظهر المنافي مع تعاليم أهل البيت  والتي أثرت في خلق نظرة قاصرة عن مفهومها الرسالي والتوعوي وأنتجت عادات وسلوكيات وأفكار تتنافى مع القواعد الدينية الثابتة، والتي عمل أهل البيت
والتي أثرت في خلق نظرة قاصرة عن مفهومها الرسالي والتوعوي وأنتجت عادات وسلوكيات وأفكار تتنافى مع القواعد الدينية الثابتة، والتي عمل أهل البيت  على وئدها.
على وئدها.
ولايعني ذلك أننا نحمل نظرة سلبية وتشاؤمية بقدر مانبحث عن مواطن الخلل لكي نقومه، لأن ماطرح حقيقة وواقع نتلمسه في زوايا المجتمع هنا وهناك، ويختلف تركزه من شريحة إلى أخرى، ولكننا نخجل أن نضع أيدينا على الجرح... وفتح الجرح.
أما المنحى الإيجابي: والذي واكب جيل سابق اتسم بالبساطة والمحافظة على قيم الدين والعرف الاجتماعي، واللاتي أتسمن بفصاحة اللسان والمنطق والمستوى العالي من الخلق الرفيع في تعاملها مع الأخريات ومناسبات أهل البيت  ، ووجود جيل ناشئ نستبشر ونتفاءل به من ثلة من الفتيات الواعيات والحريصات على تنمية مجتمعاتهم وخدمته بشتى الطرق، وإيجاد أرضية خصبة لانتهاجهن طريق الخطابة الصحيحة والواعية والسعي لتطويرها وتنويعها.
، ووجود جيل ناشئ نستبشر ونتفاءل به من ثلة من الفتيات الواعيات والحريصات على تنمية مجتمعاتهم وخدمته بشتى الطرق، وإيجاد أرضية خصبة لانتهاجهن طريق الخطابة الصحيحة والواعية والسعي لتطويرها وتنويعها.
فعمدت هذه الكوادر إلى تغيير المنهجية السائدة في المجالس والمحافل النسائية عبر برامج وأفكار ونشاطات مستحدثة كنشاطات اجتماعية وثقافية ومسرحية وتوعوية تنمي فكر المرأة وتقوم سلوكياتها وتواكب تحديات العصر المنفتح وتقف أمام تلك الأصوات التي تنادي بحرية المرأة وحقوقها وتعكس الصورة الحقيقية لمنهج وفكر أهل البيت  الذي يجسد أعلى درجات الرقي في تعامله واحترامه لمكانة المرأة وقداستها.
الذي يجسد أعلى درجات الرقي في تعامله واحترامه لمكانة المرأة وقداستها.
وكانت هذه الأسباب كفيلة في فهمهن وإدراكهن لحجم المسئولية والدور الذي تلعبه عند ممارستها لهذا الدور الفاعل والحساس. وأتمنى أن نجد هذه الفئة تكبر وتتنامى لكي تأخذ على عاتقها تغيير الحالة المأساوية التي آلت لها مفهوم الخطابة بمجتمعاتنا وحال الشريحة الكبرى فيمن يتسمون «بالملايات».
ولذلك كان لابد من تحلى الخطيبة والمبلغة بصفات ومقومات تؤهلها لتحمل المسئولية ومنها:
• التحصيل العلمي المرتفع والإطلاع على مختلف حقول المعرفة من تاريخ وأدب وعلوم عصرية وحديثة وتفسير وسيرة بالإضافة إلى العلوم الحوزوية والمعارف الدينية وخاصة فيما يتعلق بفقه الأسرة والمرأة وكتب الزواج والطلاق وغيرها من الكتب الثقافية ذات الصلة بجوانب المرأة، وعدم الاقتصار على كتب المراثي والمدح والتي عادة ماتكون الكتب التي ترجع إليها معظم «الملايات».
• أن تكون لدى الخطيبة حالة من الوعي الثقافي والفكري والذي يؤهلها للتعاطي مع الفكر المتجدد والمحيط بالفكر الديني والاجتماعي والثقافي وليس الانحسار في زاوية الاهتمام بالوعي الديني فقط، بل يتخطاه إلى أبعد من ذلك بامتلاك ملكات تنسجم مع التوجهات الفكرية الصحيحة التي تعطيها القدرة على التأثير في مستمعيها بالبعد عن حالة التعصب الديني الممقوت، وهي نقطة جوهرية أركز عليها فنحن في عصر الانفتاح الإعلامي الذي يفتح للفتاة تصورات وأفكار وتساؤلات عديدة تلج في مخيلتها وخاصة مايتعلق بالحداثة في الإطار الديني وهو مفهوم واسع بالمعلومات والمتناقضات يثري فكر المرأة وينمي ثقافتها عبر مناقشات وندوات وحوارات، وإن مثل هذه الأفكار تحتاج إلى متصديات واعيات لديهن القدرة على مناقشة الآراء وإعطاء الإجابات الصحيحة التي تعبر عن رؤى ومنهج واقعي صحيح.
• اتصاف المرشدة بالوعي والحس المرهف لما يجري حولها, والبصيرة بما يدور داخل المجتمع من مشاكل وفتن وشبهات تعصف بها وتشوش أفكارها تحت عناوين شتى ومايعتريه من ظواهر ومشاكل وأفكار مستحدثة ويعكس وعيها وإلمامها بالدور الريادي الذي تقوم به.
وهنالك متطلبات من المفترض توافرها والسعي على تفعيلها لكي ترقى الخطابة النسائية إلى المستوى المطلوب ونذكر منها:
• تفعيل دور رجال الدين والخطباء مع الجانب النسائي عبر إيجاد دورات فقهية وتوعوية من جهة، ومن جهة أخرى عمل دورات تخصصية في الخطابة وأهميتها في المجتمع عبر تغيير الحالة التقليدية السائدة عند الخطيبات والذي كان مقتصراً على دورات في الطور العزائي والأهازيج.
• وجود منهج مدروس يشجع المجتمع لمحاربة الفحش المادي الذي يواكب مناسبات الأفراح والأحزان «الفاتحة» فيما يختص بالأجر المادي لمايتسمون «بالملايات» أن صح التعبير، وهذا يحتاج لتضافر الجهود ونشر حالة التثقيف العام في جميع شرائح المجتمع بأكمله.
• إخراج الطقوس الدينية وطريقة ممارستها من الحالة التقليدية سواء مناسبات الحزن أو الفرح التي لازالت معظم «الملايات» تنتهجها وتصر عليها إلى ممارسة تحاكي واقع المجتمعات عبر برامج ونشاطات تسعى لتجسد المبادئ والقيم الدينية بنظرة راقية وسلسة تشجع الجيل الناشئ على حضورها والتفاعل معها لكي تنمو معهن حالة التثقيف الذاتي من الصغر وتعليمهن حالة الثقة بالنفس عبر تشجيع المواهب والقدرات التي يتمتعن بها وتوظيفها في إطارها الصحيح.
• تفعيل دور المثقفات والأكاديميات في جانب الخطابة والاستعانة بهن في تنمية القدرات والإمكانيات والتي لاتقل أهمية عن دور المبلغة، عبر برامج منظمة ودورات تثقيفية واجتماعية ووجود مؤسسات نسوية أهلية تخلق حالة من الوعي الثقافي في المجتمع النسائي، والتي بدأنا نلمس ظهورها وتناميها بعد ظهور مؤسسات أهلية فاعلة تعكس تنامي الثقافة النسائية والأسرية في مجتمعاتنا.
- وكلمة أخيرة أحب إضافتها:
يجب أن ندرك جميعاً أن مفهوم الوقاية خير من العلاج، وبعبارة أدق أن التحصين الذاتي أوجب من التحصين الخارجي، ومن هنا نقول لمن ينظر بمنظار ضيق ومتقوقع لما طرحناه عن هذا الموضوع: إن تحصين الكيانات الداخلية هي صمام الأمان والأساس القوي في بناء المجتمعات، فلم تعد سياسة المواجهة المباشرة مع الأفراد مجدية، بل سعوا إلى استخدام أجندة جديدة تسعى إلى خلخلة القواعد الأساسية في بناء المجتمع وهي أكثر فتكاً من مدافع وصواريخ تنفق عليها ملايين الدولارات، ومن هنا يجب أن تكون مجتمعاتنا قائمة على بناء قوي ومتين يصمد أمام تيارات وزلازل تعصف وتحاول تحطيم كيانه.