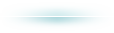لنجعله سلوكاً
ربَ تالٍ القرآن والقرآن يلعنه"!!
هكذا تحدث رسول الله  في رواية من رواياته الشهيرة التي تناقلها المسلمون حول من يلعنهم القرآن الكريم! فهل نفهم من ذلك أنه -صلى الله عليه وآله- ينهانا عن تلاوته حتى لا نُصاب بلعنته؟ أم ماذا؟
في رواية من رواياته الشهيرة التي تناقلها المسلمون حول من يلعنهم القرآن الكريم! فهل نفهم من ذلك أنه -صلى الله عليه وآله- ينهانا عن تلاوته حتى لا نُصاب بلعنته؟ أم ماذا؟
يظهر أننا نتسالم على أن هذه (الرواية) ليست بصدد نهينا عن التلاوة؛ وإلاَّ لتعارضت مع (الآيات) البيِّنات الداعية للقراءة والتدبر و...إلخ. ويبدو لي أنها -الرواية- تمثل دعوة تحفيزية صارخة لنا؛ لنعمل وفق آيات القرآن الكريم؛ ولا نكتفي بإعادة مونتاجها فقط! فالإنسان المؤمن هو من يُبرمج حياته كما أراد الله -عزَّ وجلَّ-. لذا نحن مطالبون بقراءة القرآن الكريم ضمن شروط خاصة حتى لا نُصاب بلعنته، وحتى لا نكون ممن يعنيهم الله -عزَّ وجلَّ- بوعيده إذ يقول في كتابه الحكيم: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى﴾[طه:124-126].
المؤمل منا - كمؤمنين - أن ننفتح على كتاب الله -عزَّ وجلَّ- ونقرأه؛ قراءة تدفعنا للعمل بما يأمر والاجتناب عما ينهى! فعندما نُصغي للخطاب الإلهي في مُفتتح العديد من الآيات القرآنية، ونجده يصك آذاننا بقوله -جلَّ شأنه-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...﴾ فلنقل حينئذٍ.. لبيك يا الله.. يا ربنا.. يا خالقنا.. يا هادينا.. بماذا تأمرنا؟ وعمَّا تنهانا؟ فنحن -يا الله- عبادك المطيعون.
ولعلَّه من المستحسن أن نشير هنا إلى قصة جميلة تتناقلها كتب التاريخ، مفادها، أن (الفضيل بن عياض) -وهو زعيم عصابة للسرقات وهتك الحرمات- همَّ في طريقها لاغتصاب فتاة بعد أن أخبرها بما هو عازمٌ عليه؛ فارتعدت فرائصها خوفاً، وأخبرت ذويها -الذين لا حول لهم ولا قوة أمام جبروته- بنيته. وما أن حانت ساعة الصفر، وإذا بالفضيل يسمع -أثناء تسلقه للجدار- صوتاً خاشعاً يتلو قول الحق تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ﴾[الحديد:16]. فصُعِق الرجل حينئذٍ بسماع الآية وكأنها تخاطبه شخصياً؛ فآب إلى رشده، وقال: "نعم آن"! ثم تغير مجرى حياته ليُصبح أحد العُبَّاد!!
أجل، ينبغي أن نترجم آيات الكتاب في سلوكياتنا، لا أن نقرأه قراءة من يريد أن يصل إلى نهاية السورة!
وبديهيٌ أن نقرأ في سيرة الحبيب المصطفى  أن إحدى زوجاته حينما سُئلت عن أخلاقه، قالت: "كان خلقه القرآن"!.. فماذا تعني لنا هذه الكلمات؟
أن إحدى زوجاته حينما سُئلت عن أخلاقه، قالت: "كان خلقه القرآن"!.. فماذا تعني لنا هذه الكلمات؟
ألا نفهم منها أنه  ، دعا إلى سبيل ربه، وحاور الآخر المختلف، بالحكمة والموعظة الحسنة؟
، دعا إلى سبيل ربه، وحاور الآخر المختلف، بالحكمة والموعظة الحسنة؟
ألا نفهم منها أنه  ، كان عادلاً ورحيماً! في أحكامه؟
، كان عادلاً ورحيماً! في أحكامه؟
ألا نفهم منها أنه  ، كان يعامل أبناء المجتمع الإسلامي معاملة واحدة، إذ لم يُفرِّق في معاملته بين: قرشي وحبشي، أو بين أسودٍ وأبيض، أو... إلخ؟
، كان يعامل أبناء المجتمع الإسلامي معاملة واحدة، إذ لم يُفرِّق في معاملته بين: قرشي وحبشي، أو بين أسودٍ وأبيض، أو... إلخ؟
فهلاَّ تخلقنا بأخلاقه  لنجعل من سلوكياته -وهو عدل القرآن- منهاجاً لنا؟!
لنجعل من سلوكياته -وهو عدل القرآن- منهاجاً لنا؟!
أتضرع إلى الله -سبحانه وتعالى- أن أكون وإياكم ممن يجعل من آيات ربه برنامج عملٍ يسير عليها ليحظى بالفوز الأكبر، وأسأله أن لا نكون ممن يعنيهم رب الأرباب بقوله -عزَّ من قائل-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ﴾[الصف:2-3].
فعندما نقرأ في القرآن الكريم -على سبيل المثال- الآيات الداعية إلى العدل والإحسان، أو الآيات الداعية إلى الحوار والجدال بالتي هي أحسن، فهل نجعل منها سلوكاً نمارسه، أم نكون أول من يخالفها؟
ففي القرآن مثلاً نقرأ عن (القبول بالآخر)، فهل نحن نقبل به -الآخر- عملياً أم أن قبولنا لا يتجاوز تراقينا؟! هنا المحك -كما يقال- فهل اتضح المطلب؟!