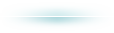التنمية المستدامة.. فاقد الشيء لا يعطيه
ظهر مفهوم التنمية المستدامة في السبعينيات، متلازماً مع إدراك العالم لمشكلة الموارد المحدودة ونشوء مشاكل بيئية في العالم المتقدم صناعياً، بسبب استنزاف الموارد الطبيعية غير المتجددة.ويتجاوز مفهوم التنمية المستدامة مجرد المحافظة على المكونات البيئية المحيطة بنا، لتشمل أيضاً الجوانب الصحية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها.
فكل البرامج التي تنظر بوعي إلى المستقبل وتراعي الآخرين وتهتم بإيجاد آليات تنمية ذاتية يمكن أن نطلق عليها برامج مستدامة.
غير أن تطبيق التنمية المستدامة على البيئة من الأمور الواضحة، خاصة حينما يتعلق الموضوع بالأشجار والغابات أو بالهواء أو بالمياه، باعتبارها مكونات ملموسة واضحة.
ويعد العالم الثالث حديث العهد بمصطلح التنمية المستدامة، ولكن ما يدعو للغرابة هو أن العالم المتقدم أمضى عقوداً طويلة قبل أن يتمكن من وضع تصورات حلول للمشاكل البيئية وفقاً لمبدأ التنمية المستدامة، إذ بدأت هذه الحركة بوضع الحلول منذ تنبهت الدول المصنعة إلى نتائج الاستخدام المفرط للموارد، حيث تنادت هذه الدول إلى عقد أول اجتماع يختص بحماية البيئة في مدينة بيرن بسويسرا عام 1913، وحينما تبلور مفهوم محدودية الموارد بعد أن نشر نادي روما سنة 1970 تقريره الذي دق جرس الخطر في المجتمع الدولي، داعياً إلى اتخاذ خطوات صارمة تتعلق بإدخال تعديلات مهمة على أساليب وخطط التنمية الاقتصادية لهذه الدول، ثم صدور تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية عام 1987 والذي أكد على أهمية المحافظة على الموارد والحفاظ على البيئة وفق منظور التنمية المستدامة، وانتهاءً بما كرَّسَه مؤتمر ريو سنة 1992، حيث أوصى بتبني ما اصطلح عليه بالتنمية المستدامة التي تقضي بإعادة النظر في أساليب التنمية اللا محدودة التي يعتمد عليها الاقتصاد المعاصر والتي تنهك البيئة وتؤثر سلباً على مصادر الحياة فيها.
محلياً تولي دولة قطر اهتماماً كبيراً ببرامج التنمية المستدامة، فقد اعتمد سمو أمير البلاد الرؤية الوطنية للتنمية الشاملة والتي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالارتكاز على التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
ومن الواضح أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، لا يمكن أن تكفي ما لم يتحمل كل منا مسؤوليته في سبيل تحقيق ذلك، إذ نعتقد أننا أمام مسؤولية كبيرة في تعزيز مفهوم التنمية المستدامة للوطن من خلال ثلاثة مسارات:
الأول: تعميق مفهوم التنمية المستدامة من خلال المناهج التعليمية، بدءاً من المراحل المبكرة.
الثاني: وضع تشريعات وضوابط صارمة للحد من التعديات على البيئة.
الثالث: تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال التنمية المستدامة وتبني الدولة لمحفزات مشجعة في هذا الصدد.
ورغم أن موضوع التنمية المستدامة يتجاوز الفهم الديني إلى ما هو أبعد، باعتباره قضية إنسانية من الدرجة الأولى، ولكن تمكن الإشارة إلى ما طرحه الإسلام من اهتمام بهذا الموضوع، حيث تجلى في إسباغ صفة المشاركة على كل ما يحيط بنا، فحينما يتحدث القرآن عن الأرض يتحدث عنها باعتبارها مكاناً مشتركاً للجميع، فقال عز من قائل: "هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا"، كما توحي الآيات القرآنية بارتباط مكونات هذه الأرض وتناسقها ضمن نظام بيئي دقيق: "والأرضَ مدَدْنَاها وأَلْقَيْنَا فيها رَواسِي وأنْبَتْنَا فيها من كلِّ شيءٍ موزونٍ"، وقال: "إن في خلق السمواتِ والأرضِ واختلافِ الليلِ والنهارِ والفلكِ التي تجري في البحر بما ينفعُ الناسَ وما أنزل الله من السماء من ماءٍ فأحْيا به الأرضَ بعد موتِها وبثَّ فيها من كل دابةٍ وتصريفِ الرياحِ والسحابِ المسخَّر بين السماءِ والأرضِ لآيات لقومٍ يعقِلون".
ودعا الإنسان إلى الاعتدال في التعامل مع الموارد فقال: "كُلُوا واشرَبوا من رزق الله ولا تَعْثَوا في الأرض مُفسِدين"، وجعل الإسلام للحيوان أيضاً نصيباً من الموارد، حيث قال: "مَتاعًا لكم ولأنعامكم".
الطموح المتقدم الذي نأمل أن يتحقق يوماً ما هو أن نبحث عن أفكار يمكن معها أن نهيئ لأجيالنا القادمة أسباب الحياة الرغيدة من خلال ابتكار موارد جديدة أو تطوير أفكار لزيادة الموارد الحالية، وهذا لا يمكن أن يتحقق ما لم نجتز مرحلة الحفاظ على الموارد القائمة والتقليل من الاستخدامات السلبية لهذه الموارد، وقديما قيل: فاقد الشيء لا يعطيه.