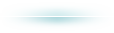علي المرهون.. وشمولية العطاء
(النجف الصغرى).. هكذا كانوا يطلقون على منطقة القطيف في السابق؛ للدلالة على علو مستواها العلمي مقارنة بالنجف الكبرى (النجف الأشرف) بالعراق التي كانت تمثل -آنذاك- قمة العلم الديني والأدبي.
احتضنت واحة القطيف، وما تزال تحتضن الكثير من الكفاءات العلمية والثقافية والاجتماعية والفنية وما شابه. هاجر من أبنائها الكثير إرواءً لظمئهم في العلم والتعلم.
وهذا "الإسهام الثقافي على توالي العصور في القطيف لم ينشأ من فراغ، ولم يولد في بيئة جاهلة، وإنما قام على دعامة وطيدة من الإلمام بمختلف العلوم والفنون، والتفاعل مع ثقافات كل عصر، ومن ثم نرى هذا الإسهام يتجلى واضحاً في التراث الذي خلفه عدد كبير من العلماء والأدباء والشعراء على تعاقب الأجيال والأحقاب"[1].
ولا أجد نفسي مضطراً لإثبات هذا التميز العلمي، فهو أمر لا يحتاج إلى أدلة كثيرة -كما يرى الشيخ عبدالعظيم المشيخص-، "لأن الحركة العلمية في أي منطقة تحمل مؤشرات أهمها:
1- وجود العلماء والرواد وطلبة العلوم الدينية.
2- الاتجاهات الفكرية.
3- الحلقات والمدارس الدينية (الحوزات).
4- الأدوار الشرعية والثقافية والدينية (القضاء، التوجيه، الخطابة، الأدب)"[2].
وهي مؤشرات تتجلى بوضوح لمن يستنطق تاريخ منطقة القطيف.
وعلى العموم فالقطيف أنجبت رجالات مجتمع، وعلماء، وخطباء، ومؤلفين، وأدباء، وفنانين، ورياضيين، و... إلخ. أحياناً على شكل أفراد، وأحياناً على شكل أسر وعائلات.
- أسرة المرهون.. مثالاً
المرهون واحدة من الأسر العلمية في القطيف، حيث خرَّجت هذه الأسرة من أبنائها كفاءات تخدم مجتمعها بعلمها وقدراتها في الخطابة والتأليف ومعالجة المشكلات الاجتماعية.
وعميد هذه الأسرة هو العلامة الشيخ منصور بن علي بن محمد المرهون (1298-1362هـ)، عالم دين وخطيب ومؤلف، له من التصانيف: القواعد العربية، ديوان المرهونيات.
وقد وِلِدَ للعلامة منصور مجموعة من الأولاد الذين برعوا في الخطابة على وجه الخصوص، إلى جانب الأدب والتأليف. وهم الأفاضل: سعيد المرهون، محمد المرهون، عبدالعظيم المرهون، محمد حسن المرهون، عبدالحميد المرهون، صادق المرهون، كاظم المرهون، وعلى رأسهم الشيخ علي المرهون.
- علي المرهون.. شمولية العطاء
ولد العلامة الشيخ علي المرهون عام 1334هـ، وعاش في كنف والده العالِم والمربي، ثم غادر البلاد متوجهاً إلى النجف الأشرف بالعراق لتحصيل العلم، متتلمذاً على يد علماء كبار كثر، منهم المرجع الديني آية الله العظمى السيد محسن الحكيم.
وحين ننعت الشيخ علي المرهون بـ(شمولية العطاء)، فإننا نريد أن نقول بأن المبدعين -في العادة- يتميزوا في جانبٍ معين؛ لا غير، فقد يبدع أحدهم في تأليف الكتب، وآخر في مجال الرسم التشكيلي، وثالث في نظم الشعر، ورابع في فن الخطابة، وهكذا.. ولكن آخرين، يبدعون في أكثر من جانب، وربما يصبح بعضهم موسوعياً؛ أي كالموسوعة التي تضم مختلف صنوف العلم وألوان الفنون، فهم شخصيات تطرق التكامل في أكثر من موقع، ويحلو للشهيد الشيخ مرتضى المطهري تسمية هذا النوع من الشخصيات بـ(الشخصية المركبة)[3].
.. وهكذا هو شيخنا المرهون، فقد تفوق في أكثر من جانب، واستطاع أن يقدم عطاءاته هنا وهناك، في هذا القالب وذاك، ظناً منه أن من يدخل البستان ربما يشتاق لشم الزهور، وآخر ربما يرتاح لمنظر الغصون، وثالث لا يستذوق إلا طعم الثمار. والبستاني الحاذق هو من يعرف كيف يصل إلى الجميع عبر اعتنائه بالجميع.
وسنركز الحديث -باختصار شديد- على جوانب العطاء التي شملتها شخصية الشيخ علي المرهون، مع الإشارة إلى كونها أدوار متداخلة في مسيرته وليست منفصلة عن بعضها البعض، وهي كالآتي:
(أ) المتعلم: منذ صغره، وهو في كنف والده، والشيخ المرهون بدأ مشوار التعلم ولم ينهه. ما كفته دروس الكتاتيب وحفظه للقرآن الكريم، فطلب الإذن للدراسة في الخارج، ثم عاد ليكمل مشوار التعلم والتثقيف الذاتي في مسقط رأسه (القطيف). وفي هذا الدور نجد همة الشيخ العالية التي أكسبته مستوى علمياً مميزاً وصيتاً طيباً عالياً.
(ب) الأستاذ: مارس الشيخ مهمة التعليم، فـ:"زكاة العلم تعليمه من لا يعلمه"[4]. وقد عمل كأستاذ مذ تواجده في مدينة النجف الأشرف بمدرسة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، وتتلمذ على يديه العديد من العلماء، واستفاد من تجربته الكثير من الخطباء.
(ج) الروحاني: اهتم الشيخ بلعب دور الروحاني في مجتمعه، في مهمة يوطد فيها علاقته بربه عز وجل، ويحث أبناء مجتمعه على توطيد تلك العلاقة الروحية مع الله سبحانه وتعالى. فكان إمام الجماعة المواظب على الصلاة في جميع أوقاتها، ولطالما سمعته فجراً يؤذن بنفسه، وذلك في مسجده المعروف باسمه بحي المسعودية في الشويكة بالقطيف، وكانت الجماعة التي تأتم خلفه كبيرة. وأذكر أني -في صغري- أول ما ابتدأت أتعلم الصلاة، كنت أذهب إلى مسجده وأصلي خلفه، وهكذا حتى صرت ملتزماً بالصلاة خلفه لفترة طويلة.
وأذكر -أيضاً- كيف أن إحياء ليلة القدر لا يحلو إلا في مسجده، حيث يقرأ السور المستحبات تلك الليلة بصوته ويصلي القدر بجموع غفيرة تملأ حتى الشوارع المحيطة بمسجده.
واهتم سماحته بالدعاء؛ الذي هو واسطة بين العبد وربه. فصنف عدة كتب فيها، منها: أعمال الحرمين، أربح التجارات في الأدعية والزيارات، أعمال شهر رمضان، زاد المسافرين في الأدعية.
(د) المؤسس: تميز الشيخ بدور المبادر المؤسس والمشجع للعديد من المشاريع الدينية والثقافية والاجتماعية، كإنشاء المساجد والحسينيات، وطباعة الكتب، وتشكيل اللجان الاجتماعية. ومن ذلك بناء مسجده الكبير المعروف باسمه، وإنشاء صندوق الدبابية الخيري الذي كان نواة جمعية القطيف الخيرية فيما بعد، "إذ كان من أوائل من دعا لإنشاء جمعية القطيف الخيرية وكانت تعرف في بادئ الأمر بصندوق الدبابية الخيري، حيث كان يدعو إليه أثناء إلقائه المحاضرات في المآتم الحسينية، وكان أول رئيس فخري للجمعية. وبدا واضحاً حرصه الشديد على الأوقاف التي تركها والده المرحوم الشيخ منصور المرهون -رحمه الله- والتي تخدم المجتمع كمغتسل (أم الخير) بأم الحمام، إذ كان دائماً ما يحث على صيانته ليبقى مركزاً لخدمة الأموات إضافة إلى اهتمامه بمغتسلي الجش والشويكة. ومن المشاريع الداعية إلى نشر العلوم الدينية تأسيسه لحسينية الشيخ منصور بأم الحمام التي أصبحت بعد وفاة والده مركزاً قرآنياً بعد أن قام بتدريس القرآن الكريم وعلومه وتأسيس هيئة لرعايتها، كذلك أنشأ مسجداً في منطقة سكناه ( المسعودية) عندما نزلها عام1380هـ-1381هـ المعروف باسم مسجد المسعودية واشتهر فيما بعد باسم مسجد الشيخ علي المرهون"[5].
وقد تعرض سماحته إلى الاعتقال لفترة من الزمن عندما سعى بالاشتراك مع والده لتأسيس حوزة دينية بالقطيف.
(د) رجل المجتمع: الشيخ علي المرهون هو من أكثر الناس الذين رأيتهم ارتباطاً بمجتمعه وارتباط مجتمعه به، "فهو وثيق الصلة بالناس دائماً وأبداً، بمواظبته على صلاة الجماعة في الأوقات الثلاثة فجراً وظهراً ومغرباً، وبمجلسه المفتوح لكل الزائرين يومياً، وبمرافقه السنوية للحجاج والمعتمرين وللزائرين للعتبات المقدسة في العراق، وبمشاركته في تشييع الجنائز والصلاة على الميت، وباستجابته لدعوة من دعاه غنياً كان أو فقيراً، وبعيادته المرضى، وحضوره لتهنئة المتزوجين، أو العائدين من السفر من أبناء محيطه. وهو يتعامل مع الناس ببساطة متناهية ودون أي تكلف، يحادثهم، ويمازحهم، ويصغي لهم، ويبادرهم بالسؤال متفقداً أحوالهم وأحوال ذويهم. ولا يشعر من تعامل معه بأي هيبة أو تميز، إنه يرفض أن يقبّل أحد يده، حيث تعود الناس على تقبيل يد العالم، احتراماً له، وإظهاراً لمكانته"[6].
(هـ) الخطيب: برز الشيخ علي المرهون كخطيب معروف، وتميز بأسلوبه البسيط في لغته، البَيِّن في فكرته وطرحه، الذي لا يخلو من مزحة أو تشويق. وقد تربى على مجالسه الخطابية أكثر من جيل، استفادوا مباشرة من توجيهاته ومواعظه ودروسه في العقائد الدينية والأحكام الفقهية.
(و) المؤلف والشاعر: وإلى جانب دور المؤلف والشاعر يتضح أيضاً دور المحقق والباحث في شخصية الشيخ المرهون. فقد اهتم سماحته بالكتاب اهتماماً بالغاً، ابتداءً بنفسه من حيث تأليف الكتب، ومروراً بغيره من حيث التشجيع والدفع باتجاه التأليف إما بحثهم مباشرة وإما بالترويج لأسمائهم ومؤلفاتهم. وما زلت أتذكر كيف أنه كان يصر على والدي الحاج الأستاذ أحمد البحراني على استكمال تأليف كتاب -قد بدأه- حول توثيق أحداث المنطقة المهمة، ولكنه لم يوفق لإكماله رغم إبدائه الاهتمام بالموضوع.
قدَّم الشيخ المرهون للعديد من الكتب، وسعى إلى طباعة وتوزيع الكثير منها، كما ألَّف هو بنفسه في عدة جوانب، فإلى جانب الكتب الروحية التي ذكرنا آنفاً؛ ألَّف في التراجم ككتبه: (لقمان الحكيم، عبدالله بن معتوق، شعراء القطيف من الماضين، شعراء القطيف من المعاصرين)، وفي القصص مثل: (قصص القرآن، قصص الأنبياء)، وفي الفقه والأصول مثل: (تقريرات على كفاية الأصول، المسائل الشرعية، الدرة في أحكام الحج والعمرة)، وفي السيرة الذاتية والرحلات مثل: (رحلتي إلى إيران، مذكرات ابن مرهون)، وفي غيرها من الجوانب، التي منها الشعر، حيث كان الشيخ المرهون شاعراً جيداً، له عدة دواوين شعرية، منها: (المرهونيات في رثاء السادات، تخميس قصيدة الحميري)، وشعره يدور في مجمله في أهل البيت  ، وفي المدح والرثاء للعلماء ورجالات المجتمع، ومن شعره هذه الأبيات في تأبين الشيخ حسن علي البدر -وهو من علماء القطيف الأفذاذ-:
، وفي المدح والرثاء للعلماء ورجالات المجتمع، ومن شعره هذه الأبيات في تأبين الشيخ حسن علي البدر -وهو من علماء القطيف الأفذاذ-:
بكاك الهدي يا حسام الهدى
وكنت على حفظه تسهر
وعج لفقدك دين النبي
وزمزم والبيت والمشعر
عليك تدور رحى الكائنات
وأنت لها القطب والمحور
فهذي المحاريب تبكي أسى
وهذي طروسك والمزبر