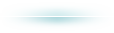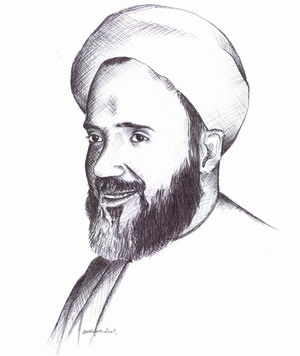مراجعة القصاص
القصاصُ حَدَث ٌ مِفصلي. ليس بالنسبة لحياة القاتل فقط. إنهُ مفصلي في حياة المجتمع كله. وفي كل مجتمع ٍ إنساني ٍ مُتحضر يُقر بحقوق الإنسان ويطبق حكم الإعدام في نفس الوقت؛ يجري فرض احتياطات ٍ قانونية و رقابة مَدَنية على عملية استصدار هذا الحكم، و إنفاذه، كي يتحقق هذا المجتمع أنهُ لن تنتزع روح أحد أفراده، إلا بحق، وأن القانون لن يتحول - ضد غايته - إلى أداة ٍ لارتكاب جريمة. القطعيّة الحادّة التي تميّز السيف وهوَ يضرب عُنق المحكوم، ليست ميزة ثابتة لكل الإجراءات التي تسبق إنفاذ الحكم: الطريقة التي يتم بها إقرار العقوبة. أسبابُ استحقاقها. آليات التنفيذ. مراحلهُ الزمنية.
خيارات المحكوم للنجاة من إنفاذ الحكم به. وساطات العفو. مَنطقها. أسباب أولياء الدم في قبول أو رفض العفو. هذه الزمرة من التفاصيل الكثيفة
التي تصحب كل حكم ٍ من أحكام القصاص في حالات القتل العمد هي ما يُحدِّدُ حقا وفي كل مرّة، ما إذا كان هذا القصاص يَصون حقوق الله وحقوق الإنسانية، أم
ينتهكها، ويؤذيها.
عندما تفجّرت قضية فتاة خميس مشيط هذا الصيف، لم تكن مفاجأة. منذ زمن ٍ كانت الأصوات تقترب من بعيد، ثمّ تعالت، ثم انفجَرَت بصخب. عبر كل خبر ٍ
كانت تنشره الصحف، وهذه الصحيفة بالذات،عن كل حالة قصاص، وتفاصيل وفود طلب العفو و ثقل الوساطات المتدخلة في الموضوع والملايين المدفوعة مقابل الدم و الأشراط الجزائية التي يضعها أولياء الدم، تشي بأن في الأمر ما يستحق المراجعة، لئلا يضيع هدف القصاص ومغزاه في غمرة تفاصيله. لن يكون هذا أمراً شاذاً إن حدث. كثير من القوانين الرسمية والأعراف الاجتماعية لدينا ضاعت بعيداً عن هدفها، ولم تعد تطبيقات العُرف أو القانون تخدم
روحه و غرضه الأصلي، وبقيت بُنيته الشكلية، مجرد طقوس ٍ تدور حول نفسها، وفَقد الضمير الجَمعي إدراكه للهدف مما يجري. وبينما يعني ضياع روح
القانون في كل مسألة أخرى الاعتداء على حق من حقوق الإنسان (و حق من حقوق الله بالطبع)،فإن ضياع روح القانون في مسألة القصاص يعني ضربَ الوجود
الإنساني الذي هو أصل جميع هذه الحقوق. إنه الضياع الأكبر.
انظر مثلاً إلى قضية (أحمد عبدالمرضي الدكاني) الذي صدَر بحقهِ مؤخرا ًحكم شرعي بالقصاص لاعترافه بارتكاب القتل عمدا بحق (ولاء) التي لم تكن تتجاوز سن الثالثة، في الدمام، مايو 2004 م. أحمد ذاته لم يكن يتجاوز سن الرابعة عشرة وقت الجريمة (الثالثة عشرة و أربعة أشهر بحسب الرسالة
الإلكترونية التي وُزعت حديثاً عن القضية). القضاء السعودي لا يلتزم بتعيين سن ٍ للرشد يُعتبر كل من هو دونها قاصراً (18 عاماً أو 21 كما في معظم دول العالم)، رغم أن المملكة شاركت في عام 2003م في صياغة "ميثاق حقوق الطفل في الإسلام" الذي يحدد بوضوح أن للطفل مراحل عُمرية هي الطفل غير
الـمُميِّز (دون العاشرة)، ثم الطفل المُميِّز (فوق العاشرة و دون البلوغ)، ثم البالغ. و تشترط ألا يتم إيقاع عقوبة على الطفل الـمُميِّز إلا بعد محاكمته بواسطة قضاء مختص ثم إعادة النظر في الحكم بواسطة سلطة قضائية أعلى، و استشارة الخبراء الاجتماعيين، و في جميع الحالات "مراعاة سنه و حالته و ظروفه"، و ألا يزيد الحكم بعد كل ذلك عن إدراجه ضمن برنامج إصلاحي، أو عقوبةٍ مخففة. هذه هي بنود الاتفاقية التي شاركت المملكة في صياغتها و تبنتها، و"تبني اتفاقية ما بمرسوم ٍ ملكي يوافق عليها يجعلها جزءا من الحكم الداخلي الذي يُحتج بهِ أمام القضاء". و هذه ليست الاتفاقية الوحيدة. هناك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي انضمت إليها المملكة في عام 1996م "مع التحفظ على ما يُخالف الشريعة الإسلامية فيها".
اتفاقية الأمم المتحدة تقول بوضوح إن "كل من هو دون الثامنة عشرة يعتبر طفلاً"، لكن التحفظات الشرعية لا تأخذ من هذه النقطة بالغة الأهمية موقفاً
واضحاً، و لا تحدد ما إذا كانت تقر بطفولة من هو دون الثامنة عشرة أم لا، لكنها تشير إلى سن الحلم. ما هو سن الحلم بالضبط؟ 14 أو 15 أو 16؟ إنه ما لا يمكن ضبطه بسن ٍ معينة. لكن القوانين الـمَدَنية السارية في المملكة تقول بوضوح - عكس كل ما سبق - إن ابن الرابعة أو الخامسة عشرة طفل.
مجرد طفل. ليست له ذمة مستقلة و لا هوية مستقلة. لا يحمل بطاقة أحوال و اسمه ما يزال ينام وديعاً أسفل اسم أمه في بطاقة العائلة. و إذا ذهب إلى
أي مكان ٍ لتخليص أي شأن لن ينظر له أحدٌ بجدية و سيُقابل دائما بعبارة "وين ولي أمرك؟". يقضي وقته في اللهو بالألعاب العنيفة على البلاي
ستايشن خاصة، وتقبض عليه الشرطة إذا ضبطته متلبساًًَ بقيادة سيارة والده لأنه لا يُمكن استئمانه حتى على سيارة. نعم. لا يُمكن استئمانه حتى على
سيارة من حديد. لكن يُمكن الحكم عليه بالقصاص إذا قتل. وهذا هو ما يحدث لـ(أحمد عبدالمرضي الدكاني) الذي ارتكب ما ارتكب وهو أقرب إلى طفولته
منه إلى رجولته. في تقرير المتابعة الذي رفعته المملكة إلى لجنة حقوق الطفل عام 98م، تعهدنا أننا لن نوقع القصاص على طفل. فهل يعني هذا أننا
لن نعاقب من ارتكب جريمته في سن الطفولة؟ أم يعني أننا سنصدر الحكم وننتظر من ارتكب جريمته طفلا حتى يكبر و يصبح بالغا لنعود فنقتص منه على ما ارتكبه طفلا؟ هل يبدو في كل هذه الأحجية المضطربة ذرة من عقل ٍ أو عدل ٍ أو ضبط ٍ يليق بالتشريع الرباني وبالقضاء وبالمضمون الإنساني الرفيع
اللذين يحميانه؟.
مثل ضربة على سطح ماء ٍ ساكن تصنعُ دوائرَ تتسع و تتسع. إذا فقد القانون روحه انتقلت الموجة إلى الناس ففقد ذات القانون مغزاه بالنسبة لهم.
فالقانون الذي لا يحرص على إنسانية الإنسان داخل المحكمة لن يجعل الناس يحرصون عليها خارجها في أخلاقياتهم. متعلقات القصاص التي تجري خارج المحكمة لا تقل ضياعا وفقدانا للمعنى. انظر إلى مسألة العفو التي تغلب عليها في التشريع الرباني صبغة التصدّق ولا بأس في التعويض المادّي، كيف
تتحوّل إلى مسألة مادية صرف عندما يصل ما يُدفع مقابل العفو إلى مليوني ريال أو ثلاثة أو أكثر. وكيف يُصاحب هذا اشتراطات ٍ مثل إجلاء القاتل و أهله عن المدينة وهو ما يعني ضمنا معاقبة أشخاص لا ذنب لهم إلا أنهم عائلة القاتل وحسب. و انظر كيف تتعقد مسألة العفو ضميرياً عندما تصبح الوساطات المقبولة و التي قد يسمع منها أهل القتيل هي بالذات وساطة الأعيان و الوجهاء، فلا تعود تدرك غرض أهل القتيل من إيقاف هؤلاء ببابهم، ولا غرض هؤلاء من الوقوف بباب أهل القتيل. وكيف لا تكون سيرة القاتل وصلاحهُ أو فسادهُ هي الأسباب الموجبة للعفو بل حجم وساطاته و مدفوعاته. و انظر بسبب كل هذه المعايير المضطربة كيف تتسع فرصة ابن القبيلة ذي الصلات الواسعة في الحصول على العفو إذا قتل، وتضيق فرصة القاتل وتكاد تنعدم لو كان مجرد عامل ٍ آسيوي مغترب لا يعني العفو عنه شيئا لأحد، لا مال، لا صيت، لا شيء. حتى لو كان في ظرفهِ و شخصهِ أكثر استحقاقاً للعفو و ميلا إلى التوبة و الصلاح.
ما فعله والد منذر القاضي العام المنصرم أو ما فعله فهد السهر في القريات هذا العام. تقديم العفو لقاتل ٍ يافع ٍ تائب، صدقة خالصة ترفع لوجه الله تعالى: إنها بعض الأعمال الصالحة التي تشرق في هذا الضباب بين وقتٍ ووقت، لكنها لا تبدده بل تظهر حقيقته التي هيَ أكثر كثافة مما يبدو بكثير.