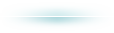الدين … رأس الحربة في وجوه الأعداء
دعونا نتأمل الأحرف الخمسة التالية: (الدين). ذلك الشيء المغروس فينا جميعا منذ الأزل ، فلا شك أنه بالنسبة لنا جميعا يتجاوز حدود كونه ثقافة أو عادات أو تقاليد. فالدين بعد نزع كل التفاصيل ذات البعد الثقافي الممكنة منه ، يغدوا شيءً بسيطا ، نعبر عنه حقيقة بأنه: (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون).
و من هنا يمكن أن ينطلق قولنا أن الدعوة لإقصاء الدين بما هو دين بمفهومه البسيط ، من واقع الحياة ، أشبه بالوهم و السراب. فالدين باقٍ ما بقي الإنسان ، و عزله في المنازل أو الكنائس ، لا يعدو كونه محاولة تحجيم يائسة فقط لا غير. و سيبقى الناس دائما متدينون بنسبة ما ، أو الأصح أن نقول بنوع ما من التدين. فحقيقة المشكلة مع الدين ليست في أصلها قضية بتره من واقع حياة الناس ، أو دمجه معها. بل المشكلة الحقيقية كامنة في تفاصيل كل دين ، فكما يقال: 'الشياطين تكمن في التفاصيل'. إن الدين حقيقة واحدة ، و نزعة بشرية موحدة ، من حيث الأصول. لكن الثقافة تصنع منه أشياء متعددة ، يمكن أن يكون بعضها سوي بناء ، و بعضها الآخر يمكن أن يكون تخبطا أعمى ، قد لا يناسب حتى المجانين من الناس. ولأن الدين واقع حقيقي في الداخل ، فلن يبقى إذا بدون إفرازات خارجية تطفوا على السطح على شكل ثقافة دينية تعبر بالضرورة عن طبيعة التدين الذي يتبناه كل إنسان.
إن أبسط تقريب ممكن لحقيقة الدين من وجهة نظري ، هو تشبيهه بغرائز الناس الفطرية الأخرى ، كغريزة الجنس مثلا. فليس صحيحا أن ننادي بإلغاء هذه الغريزة أو القضاء عليها ، بل الصحيح أن ننادي بعقلنة تلك الغريزة ، أي تقنينها ، و ضبطها ، ضمن حدود الممارسة السليمة التي تقود الفرد و المجتمع معا نحو السعادة و النمو و الرفاه ، دون إلحاق الضرر بالعلاقات البينية لأفراد المجتمع ، و أيضا دون تجاهل الاحتياجات الطبيعية لأفراد المجتمع أيا كانوا ، قدر الإمكان. أما السماح لكل إنسان أن يتبع غرائزه كيفما شاء ، فيجثوا فوق كل دابة و كل بشر شاء ، دونما عقل ، و دونما حساب ، و دونما مراعاة لنظام تطور المجتمع ، فهذا غباء ما بعده غباء ، لا يحقق إلا مصالح خاصة ، في مواقف خاصة ، لبعض الأفراد ، و نتيجته النهائية دمار المجتمع و الأفراد على السواء. و هذا ما لا يمكن أن يرتضيه إلا مجتمع المجانين و السفهاء. وعلى هذا الأساس يمكن أن نتعامل مع (غريزة التدين) لدى الأفراد لنفهمها جيدا ، فلا نتيه في مسارات جدل اعتباطي غير بناء.
فنحن هنا عندما نقف أما غريزة التدين يجب أن نفرق بين ثلاث حالات: أولها: قمع هذه الغريزة و القضاء عليها أو كبتها تماما ، و ثانيها: إطلاقها بحرية تامة و عبثية مطلقة و غباء ، دون وعي أو فهم ، و ثالثها: تقنينها و إخضاعها للعقل و المنطق. و أتصور أننا جميعا يمكن أن ندرك أنه من أجل هذه الأخيرة حارب و قاتل جميع الأنبياء و الرسل و المصلحون الربانيون ، كافة الأشكال الأخرى العمياء.
إن غريزة التدين ببساطة أيها الإخوة العصريون ، ليست شيءً يصح القضاء عليه أو محاربته. فهي فطرة بشرية ، و حاجة إنسانية ، لا فرار منها أبدا ، ما دام الإنسان عارفا بعجزه و ضعفه و حاجته إلى الله ، مقرا بذلك. لكن ما يمكن قبوله و التسليم به ، هو ضرورة إقصاء و تحجيم و عزل الثقافة الدينية في أماكن العبادة و الحياة الخاصة للأفراد ، عندما يكون المقصود تلك الثقافة الدينية الخاطئة ، المريضة ، مصدر الشرور ، و الويلات ، و معاناة البشر. و عندما فقط تكون السبيل إلى ثقافة دينية صحيحة موصدة تماما. فعندها قد يصح إقصاء ذلك الدين أو تلك الثقافة الدينية الخاطئة ، و قصرها على الأفراد ، و دور العبادة ، و عزلها عن الحياة العامة لبني البشر. و مثال هذا ربما ما يطبق في المجتمعات الغربية ، و الموقف المتخذ هناك حيال تداخل دور الكنيسة مع الحياة العامة العلمية و السياسية و الاقتصادية لتلك المجتمعات.
لقد لبِسَ الجهل و الاستبداد و التخلف و الظلم كثيرا ، ثوب الطهر و التدين و النقاء. فلقد نادى فرعون في الناس (أنا ربكم الأعلى) ، و كان (يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم). و كان مشركوا الجاهلية يقدسون البيت الحرام ، و يعبدون التماثيل التي يعتبرونها آلهة ، و كانوا يقولون (أألهتنا خير أم هو). وكانوا في نفس الوقت أيضا يستضعفون البشر ، و يتعرضون لهم بالإهانة ، فيقولون (أنؤمن كما آمن السفهاء) ، فيستضعفونهم ، و يستعبدون طائفة من الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فكانت حرب الرسل و الأنبياء دائما ، حرب الخير و المنطق و العقل ، ضد الشر و التخلف و الجهل و السفاهة و الاستبداد و الظلم ، ولم تكن يوما من الأيام عكس ذلك ، إلا في أذهان السذج و الأغبياء.
و لو لم تكن أمامنا تجارب الرسل و الأنبياء ، لربما جاز لنا حينها أن نفهم الدين خلاف العقل و المنطق ، و خلاف ما شهدناه مطبقا على أرض الواقع عبر ما تناقلته صفحات التاريخ من رقي و تحضر و منطق بناء و وعي و حرب على التخلف و الجهل و الظلم. لكن ذلك لم يحصل ، فكيف يراد لنا أن نفهم الدين بغباء؟!. إن الله سبحانه لم ينزل على البشر قرطاسا يتلى ليؤوله الجهال بغباء ، بل أنزل كتبه و كلامه على قلوب الرسل و الأنبياء ، ليكونوا هم من يعود إليهم الناس في فهم دينه و تأويله بالعقل و المنطق ، لا بالجهل و التخبط ، كي تتحقق بذلك الهداية ، و تقوم الحجة على الناس ، فيعي الناس ، و يفهموا ، أن هدف الدين هو بناء الحياة ، فلا يزيغ الناس في متاهات اللغة و مجازاتها ، إلا وقد أقيمت عليهم الحجة الدامغة ، أن هذا التخلف خلاف رضا الله سبحانه.
لقد اقتضت مشيئة الله سبحانه أن يستخلف الإنسان ، بعد أن يختار إلى جواره الرسل و الأئمة و الأنبياء. فلم يبق من بعدهم أمام الناس إلا الكتاب المنزل ، و نور العقل ، و شيء من بصيص نور خافت من تجارب الأنبياء امتد عبر الزمن ، ليعلم الناس كيف يعيشون دينهم ، رغم التحريف و التشويه الذي طال تجارب الأنبياء (عليهم السلام).
وهنا وقع الناس في الحيرة أمام خطين من الدين ، بل خطوط متعددة منه ، أفرزت أغلبها عوامل المصالح و التخلف و الشهوات و السياسة و الجهل و الظلم. و ربما جاز لنا اختصارها جميعا في نوعين أو خطين رئيسين من الدين هما: (دين العقل و دين الغباء و الجهل) ، وقد اشتبهت هذه الخطوط على الناس و تداخلت ، فأصاب الناس منها لبس عظيم ، فلم يعد الواحد منهم يعرف كيف يفرق بين تدين الغباء و تدين الذكاء.
لقد سئل أحد المشايخ ذات مرة عن 'الليبرالية' ، فقال 'ماذا ... الريبرارية ...اللبراررية' ، وهنا انبرى المحاور لبيان ما تعنيه هذه الكلمة ، فما كان من الشيخ حفظه الله إلا أن تفضل بإعطاء الجواب و الشرح الوافي ، الذي سماه البعض تأصيلا شرعيا. وهنا نقول: 'تأصيل شرعي أم جهل بالواقع ، و غياب عن قضايا الحياة'. إن الحقيقة الواقعية هنا هي أن البعض يكتفي بتعلم فنون اللغة العربية ، و حفظ آيات القرآن الكريم ، و متون الأحاديث الشريفة ، و يغض الطرف عن وعي الواقع ، بل حتى عن مجرد الإطلاع على علوم و مجريات العصر ، ثم يقدم نفسه للإفتاء باعتباره عالما بليغا خبيرا بما تريده السماء ، و كأن الوحي يتنزل على من يشاء ، فأين تتنزل حيثيات و ضرورات الزمان و المكان ، إذا؟!.
لقد اشترط العلماء و المراجع الكرام في رسائلهم العملية العقل كضرورة لازمة في شخص مرجع الدين ، و لا أظنهم سيخالفوننا أيضا إن قلنا أن المرجع الديني يجب أن لا يكون أيضا قاصر العقل أو مصابا بحالة نفسية قد تؤثر في قواه العقلية ، بل أظن هذا من حتمية كونه عاقلا بلا شك. لكن ما الفائدة هنا إن كان عاقلا ، و لا يفقه ما يجري من حوله من شؤون الحياة ، من تطورات و تغيرات: ثقافية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو علمية ... الخ. ثم أيضا أَنـَّا لبشر أن يستوعب بمفرده كل هذه العلوم و التطورات العصرية المتضخمة ، دون أن يقع في خطأ أو لبس أو قصور واضح.
لقد قصَّرت الحوزات العلمية بلا شك ، في تطوير حالة المرجعية ، و تحويلها من قيادة الفرد و الزعيم الأوحد ، إلى قيادة فريق العمل ، و تجاهلت نداءات العلماء الفضلاء الذين طرحوا بعض التصورات و الحلول التطويرية لواقع المرجعية الدينية. لذا أصبحت المرجعية بحكم الأمر الواقع قاصرة عن أداء الدور المأمول. وليت المرجعيات الدينية إستفادت من تجربة حزب الله مثلا الذي صنع القائد البطل من خلال العمل الجماعي ، و الفريق المختص ، و الكادر المتكامل. فاستطاع أن يحقق انتصاراته المؤزرة بإذن الله. فهنا يبرز مبدأ واقعي ، و طريقة سليمة ، تحدد ملامح ضرورية لنجاح القيادة و فاعليتها ، أيا كانت تلك القيادة ، دينية أم وطنية أم سياسية أم اقتصادية أم غيرها ، فالمهم هنا المبدأ. و لست أظن حزب الله مثلا ، يختصر النصر في شخصية سماحة قائده السيد حسن نصر الله ، إذ لا تكفي سيطرة القيادة الحكيمة الواعية على دفة التوجيه و القرار ، دون وجود مشاركة حقيقية لصيقة من الكفاءات و الكوادر المتخصصة المطلعة مباشرة أيضا بمهمة توجيه القرار و قيادة الأمة نحو أفضل رأي و أصوب خيار ، بل لا بد فوق ذلك من الارتباط المباشر و الانفتاح الحقيقي على القواعد الشعبية أيضا. لكننا تعودنا في مجتمعاتنا العربية و الإسلامية على استبداد السلطة الدينية منفردة بالقرار ، وهذا ما يجب أن نعيد تأمله جيدا ، فلست أظنه إلا منهجا باطلا.
لقد علمنا الأنبياء أن نقود الدين أو أن نفهمه و نوجه معانيه بتفعيل طاقة العقل أي بالحكمة ، التي بدونها لا يتحقق الفقه و لا الاجتهاد. لكن بعض المسلمين اليوم على الأقل ، ركبوا الدين ركوبا أهوجا. فهل يصح أن نسلم دفة القيادة لشخص سفيه يوجه سيارة مثلا دائما باتجاه الأخطار ، فيرتطم بها مرة في عمود ، و أخرى في جدار. ألم يعلمنا الأنبياء و الأولياء أن المؤمن يجب أن يكون (كيسا فطنا) ، لا (كيس قطن) كما قد يتصور البعض من البلهاء. و أنا أنزه العلماء عن الغباء و الجهل و قلة الورع ، لكن من استبد برئيه هلك ، ونحن لم نخلق نظام مشاركة جيد بعد ، وهذا من الناحية الواقعية يسمى استبداد ، و هو يؤدي بالضرورة إلى الهلاك.
إن الحقيقة التي يجب أن تكون حاضرة أمام أنظار الجميع ، هي أن الدين له جوف ، و في جوفه هذا يجب أن يستقر العقل و المنطق ، كي يكون التدين تدين عقل و فهم ، فلا يصح أن نسمح أن يدخل جوفه هذا شيء أخر فاسد ، قد يكون سلطة سياسية فاسدة تنتج وعاظ السلاطين ، أو عقول خالية من الوعي و مليئة فقط بقشور الدين و بالجهل ، فتنتج علماء الجهل ، فعندها تحل الطامة الكبرى ، فيفسر الدين بشكل منكوس أو مشوه ، لا يصدر منه إلا الفساد و التخلف ، لا الخير و السلم و الرقي و الحب و الرفاه.
وعندها نعود للدين الذي جاء به فرعون ، أو عبدة الأوثان ، الذي هو دين الجهل و التخلف و البغي و الغل. ذلك الذي أراد أنبياء الله أن يعلمونا كيف نحاربه و نتخلص منه دائما ، لنصل بالتدين إلى حقائقه الناصعة التي يجب أن تكون واضحة و مفهومة أمام المنطق و العقل ، خصوصا بعد التجارب الملحوظة التي خاضها الأنبياء و الرسل العظماء ، و بعد الحجج الواضحة.
وهنا أرجوا أن لا أكون قد أنهيت المقال قبل أن يفهم القاريء العزيز بوضوح ، موقعية العقل الكبرى في دين الله ، و دوره القيادي فيه ، و ما يجب أن يشهده الواقع من دلائل صدق دعوى الدين الذي يراد له أن يكون دين الله الحاكم بالحق فوق هذه الأرض ، المنقذ للجنس البشري ، رأس الحربة في وجه التخلف و الجهل و الظلم و الانحطاط ، باني الأمم ، حامي وحدة المجتمع ، و المدافع الأول عن الوطن. و لست أريد أن أختم أيضا قبل أن يكون القاريء العزيز قد استوعب حقيقة الدور الخطير الذي يجب أن يلعبه رجال الدين و المراجع العظام و الحوزات العلمية و النظام الذي يجب تطويره بتكاتف الجميع فيها ، كي لا نتحول كما هي الحال مع بعض الديانات و التوجهات الخاطئة ، إلى سبة و لعنة في تاريخ الأمم و الشعوب ، تتبرأ منها الأجيال. فإن دين الله لم يأتي عبطا ، و لم و لن ينطلق أبدا من أدمغة الحمقى و المغفلين ، و لن يكون دينا حقيقيا أيضا ، إلا إذا استطاع أن يكون (واقعيا منتجا و صالحا فوق أرض هذه الحياة). أما ما عدا ذلك فلن يكون إلا تشويها و صورة مزورة عن الدين. فأرجو بذا أن أكون قد وفيت ، و أسقطت عن كاهلي عبء مسؤولية البلاغ للمخلصين من جنسنا البشري ، الذين قد يحتاجون هذا البلاغ ، و الله المستعان.