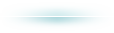(16)
نَبِّئْ عِبادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
عندما يقترف الإنسان الذنوب والمعاصي، وينزلق في منحدر الشهوات، فإنه قد يصل أحيانا إلى حالة من اليأس من إصلاح نفسه، وأنه لا سبيل له للعودة إلى ربه. وبناء على هذه القناعة الباطلة، فإنه يستمر في غيه، فيرتكب الإثم بعد الإثم، والخطيئة تلو الخطيئة.
ولكن الله تعالى في هذه الآية يكلف نبيه  أن يوصل للناس جميعا، باعتبارهم عبادا له، رسالة عظيمة مفادها أنه هو الغفور الرحيم. وهنا وقفات:
أن يوصل للناس جميعا، باعتبارهم عبادا له، رسالة عظيمة مفادها أنه هو الغفور الرحيم. وهنا وقفات:
الوقفة الأولى: استعمل صيغة (فعّل) بدل صيغة (أفعل). والفرق بينهما كما يذهب إلى ذلك الدكتور فاضل صالح السامرائي في كتابه: (بلاغة الكلمة في التعبير القرآن، ص65، دار ابن كثير، الطبعة الثانية 2016) إن (فعّل) يفيد المبالغة والتكثير غالبا نحو قطّع وفتّح وكسّر وحرّق وسعّر، قال تعالى: (وَقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً . أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ خِلالَها تَفْجِيراً). فقال في الينبوع (تَفْجُرَ) بالتخفيف، وقال في الأنهار (فَتُفَجِّرَ) يالتضعيف للكثرة. انتهى.
ولعله لذلك قال تعالى: (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ)، ولم يقل (أبلغ).
أما هنا فقال: (نَبِّئْ عِبادِي) ولم يقل (أنبئ)، وذلك لأهمية النبأ، وللحاجة الدائمة للتذكير به.
الوقفة الثانية: قوله: (عِبادِي) ، فالنسبة تشريفية. وفي ذلك تنبيه للناس بما هم عباد لله بأن الله قريب منهم، وأن عليهم استشعار هذه الحقيقة، والعمل وفقها. قال تعالى: (وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) وقال: (قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ).
الوقفة الثالثة: ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب: "أنه لما ذكر الرحمة والمغفرة بالغ في التأكيد بألفاظ ثلاثة: أولها: قوله: أَنِّي. و ثانيها: قوله: أَنَا. و ثالثها: إدخال حرف الألف واللام على قوله: الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. ولما ذكر العذاب لم يقل إني أنا المعذِّب وما وصف نفسه بذلك بل قال: وَأَنَّ عَذابِي هُوَ الْعَذابُ الْأَلِيمُ".
الوقفة الرابعة: ما ذكره صاحب الميزان في تفسير الآيتين (نَبِّئْ عِبادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَأَنَّ عَذابِي هُوَ الْعَذابُ الْأَلِيمُ): "وتأكيد الجملتين بالاسمية وإن وضمير الفصل واللام في الخبر يدل على أن الصفات المذكورة فيها أعني المغفرة والرحمة وألم العذاب بالغة في معناها النهاية بحيث لا تقدر بقدر ولا يقاس بها غيرها". وبناء على ذلك تكون الوقفة التالية.
الوقفة الخامسة: إن على الإنسان دائما في علاقته مع ربه أن يكون بين الخوف والرجاء، كما قال تعالى: (أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخافُونَ عَذابَهُ إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ كانَ مَحْذُوراً). وفي الرواية عن الإمام الصادق  من وصية لقمان لابنه: خف الله خوفا لو وافيته ببر الثقلين خفت أن يعذبك الله ، وارج الله رجاء لو وافيته بذنوب الثقلين رجوت أن يغفر الله لك.
من وصية لقمان لابنه: خف الله خوفا لو وافيته ببر الثقلين خفت أن يعذبك الله ، وارج الله رجاء لو وافيته بذنوب الثقلين رجوت أن يغفر الله لك.
هكذا ينبغي أن يكون الإنسان في حالة توازن من عدم القنوط من رحمة الله أو اليأس من رَوحه: (إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكافِرُونَ) وعدم الأمن من مكره: (ِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ).
الوقفة السادسة: المغفرة والرحمة مقدمان على العذاب الأليم (يا من سبقت رحمته غضبه). وفي هذا ترغيب للإنسان لسلوك الطريق الموصل لرحمة الله ومغفرته، فهو تعالى خلق الخلق ليرحمهم، لا ليعذبهم: (ما يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكانَ اللَّهُ شاكِراً عَلِيماً).