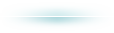العقل العربي والثقافة الزائفة
أظهرت الكثير من الأحداث التي جرت أخيراً ضرورة إجراء مراجعات كبرى للعقل العربي، ليس لأن ذلك شرط في تحقق عوامل النهضة فقط، بل لأن العقل العربي أثبت عدم قدرته على فهم الواقع ومجرياته، وفشله الذريع في إعطاء قراءة محايدة للأحداث المصيرية، وسكون الهم الطائفي والقومي في تفسيره للأحداث الكبرى، وإذا كان كذلك فلا يمكن إنجاز مشروع نهضوي يهتم بالأمة ككل، مع احتضان الاختلافات العرقية والقومية والمذهبية والإقليمية.
إن العقل العربي تلبس مذ أمد بعيد بثقافة الاستبداد والنظرة الأحادية، التي تلغي فهم الآخر، ووجوده وآلامه وأحزانه، وأصبحت الأمة مجتمعات متفرقة متشتتة، وتحول قانون التعارف إلى ضده « التناكر والتدابر»، ولم تعد الأمة تشعر بالوحدة، وأصبح لكل جماعة همومها وتطلعاتها بعيداً عن السياق العام للأهداف والتطلعات والآلام، فإذا اشتكى شعب أو مجتمع أو جماعة من الأمة من المحنة والكبت والارهاب واستبداد الحاكم لم تشعر المجتمعات الأخرى بذلك، بل إذا غمر شعب الفرح ترى الطرف الآخر خارج سياق المشاركة الوجدانية لهذا الشعب أو ذاك، كما لا حظنا ذلك في الحدث الأخير «القبض على صدام حسين»، حيث غمرت الشعب العراقي الفرحة لهول ما عاناه من آلام وقتل وتشريد وكبت وإجرام من طاغية العصر، لكن شعوباً عربية أخرى خرجت عن سياق مشاركة الشعب العراقي الفرحة، وتحولت للنقيض، وهذا ما يدعونا لقراءة جديدة للعقل العربي، ويطرح تساؤلات كبرى بحجم الحدث، فهل يقدس العقل العربي الاستبداد ؟ وهل من الصحيح أن الفكر الإسلامي يكرس النظرة الأحادية ونبذ الآخر؟ وهل المستبد وليد ثقافة أم وليد سلوك أمة ترضى بالذل وتعشق المستبد، كما لاحظنا حالات البكاء والإغماء التي رافقت تشييع حكام رحلوا إلى دار البقاء؟! هل من المعقول أن ينوح السجين على جلاديه؟!!
الأصول الثقافية التي ترسم لنا التطلعات وتحدد لنا الأهداف، هي التي تجعلنا نتخذ هذا الموقف دون ذاك، ونتعاطف مع هذا الشخص دون غيره، ومن أهم تلك الأسس الثقافية ما يرتبط بتحديد الحاكم الأقدر والأكثر كفاءة على تأدية دوره وتفهم مجريات الأحداث المصيرية ومن ثم الانطلاق نحو التطور والتقدم دائماً، وقد بحثها علم الكلام الإسلامي تحت عنوان «الإمامة السياسية»، وكان اتجاهان رئيسيان سيطرا على العقل الكلامي، أحدهما تزعمته مدرسة أهل البيت ، والآخر تزعمته السلطة، مدرسة الخلفاء، التي كانت نظريات عديدة تحكم رؤيتها تجاه الحاكم، لكن نظرية الواقع يشرعن السلطة هي الحاكمة على العقلية العربية، فما دام الحاكم مسيطراً على مقاليد الحكم والقوة فهو وإن كان «فاسقاً أو فاجراً» لا يجوز الخروج على ولايته، وقد مهدت هذه النظرية وأرست الأسس العامة للاستبداد وضرورة التعايش معه، وأنه ليس بالإمكان أفضل مما كان، وبهذا أصبح الاستبداد والكبت والقهر هو ما تنتجه السلطة وما برعت فيه خلال تاريخنا القديم والمعاصر.
، والآخر تزعمته السلطة، مدرسة الخلفاء، التي كانت نظريات عديدة تحكم رؤيتها تجاه الحاكم، لكن نظرية الواقع يشرعن السلطة هي الحاكمة على العقلية العربية، فما دام الحاكم مسيطراً على مقاليد الحكم والقوة فهو وإن كان «فاسقاً أو فاجراً» لا يجوز الخروج على ولايته، وقد مهدت هذه النظرية وأرست الأسس العامة للاستبداد وضرورة التعايش معه، وأنه ليس بالإمكان أفضل مما كان، وبهذا أصبح الاستبداد والكبت والقهر هو ما تنتجه السلطة وما برعت فيه خلال تاريخنا القديم والمعاصر.
وهنا يتحول المستبد إلى منقذ، وبطل، وقائد تاريخي، وتاريخياً يتحول إلى أمير المؤمنين، وظل الله في أرضه، ولا يهم أنه يقترف كل المنكرات ويتجاهر بكل المعاصي، كما فعل يزيد بن معاوية الذي قتل صحابة الرسول في وقعة الحرة في المدينة واستباح المدينة لجيشه ثلاثة أيام انتهكت الأعراض وقتل خيرة المجتمع المدني، والذي قام بهدم الكعبة، وقتل سبط الرسول وريحانته
في وقعة الحرة في المدينة واستباح المدينة لجيشه ثلاثة أيام انتهكت الأعراض وقتل خيرة المجتمع المدني، والذي قام بهدم الكعبة، وقتل سبط الرسول وريحانته  وأهل بيته، هنا يتحول يزيد من خلال تنظير هذه المدرسة السلطانية إلى أمير المؤمنين، وبالطبع إذا كان يزيد أميراً للمؤمنين، فلا محذور من تولي السلطة من لا يملك أدنى مقومات الحكم والوعي السياسي والكفاءة على تخطي الأزمات.
وأهل بيته، هنا يتحول يزيد من خلال تنظير هذه المدرسة السلطانية إلى أمير المؤمنين، وبالطبع إذا كان يزيد أميراً للمؤمنين، فلا محذور من تولي السلطة من لا يملك أدنى مقومات الحكم والوعي السياسي والكفاءة على تخطي الأزمات.
وقد أسهمت النظريات السلطانية في تطبيع علاقة العقل العربي مع الحاكم المستبد فاعتبره ضرورة توليها الظروف الحساسة التي تمر بها أمتنا، بل خرج علينا حتى المصلحون كجمال الدين الأفغاني ليروج لنظرية «العادل المستبد»، وهذا الأمر يظهر شدة التأثر بالتراث المنتج داخل المؤسسة الفقهية السلطانية، التي برعت كثيراً في تضليل العقل العربي وروجت لثقافة شعبية تقدس المستبد وتبكي على أطلاله، وكانت في النهاية تستهدف التبرير الأيديولوجي للمؤسسة السلطانية، ولم يكن أثر التراث منحصراً في الماضي، أو في دولة الخلافة، كلا بل امتدت هذه الثقافة والأيديولوجيا إلى عصرنا الراهن حيث استدعى الحاكم العربي كل تلك المقولات التاريخية التي أنتجتها المؤسسة الرسمية الفقهية لدولة الخلافة، وجعل الخروج على مدلولاتها هرطقة وزندقة وتطرف.
إن الاستبداد والكبت والقهر هو الذي ينتج التطرف والارهاب، لأن المجتمع عندما يفقد قنوات التعبير الحر، وعندما ينتج السلطان ثقافة نبذ الآخر على أساس عقائدي أو قومي أو عرقي، هنا وبصورة طبيعية يتولد العنف وتتولد الاتجاهات المنحرفة أو التي تمارس الإرهاب سواء باسم الدين أو تحت أية واجهة أخرى، ولا يمكن للأيديولوجيا التي تبرر للسلطة المستبدة أن تحل تلك الأزمات، الإرهاب، التطرف، العنف، كما أنها لم تستطع حل ذلك تاريخياً، بل كان الاستبداد سبب سقوط الأنظمة والحكومات ليس في التاريخ العربي والإسلامي فحسب بل في تاريخ الإنسانية جمعاء.
لابد من قراءة واقعية وموضوعية لظاهرة التكيف العربي مع السلطة المستبدة، ومن المهم أن نحدد أسباب وعوامل خدمة العقل العربي متمثلاً في النخبة المثقفة لظاهرة الاستبداد عبر تاريخنا، فقد مثل المثقفون إلا ما ندر الأداة التي يبرر بها السلطان فعاله، وكانت كتب الآداب السلطانية التي أنتجتها ثقافة السلطة متمثلة في الوعاظ والفقهاء الذين كانوا يرتزقون من بركات المستبد تسعى لنشر ثقافة الطاعة العمياء بين عامة الناس، وبالطبع لا زالت تلك الثقافة ساكنة في العقل العربي، وهي التي تحدد لنا تطلعاتنا وسلوكياتنا، وما البكاء على الحاكم العربي عند رحيله عن الدنيا والذي شهدناه في أكثر من بلد إلا مؤشراً على تغلل تلك الثقافة الزائفة في عقلنا العربي، وما دامت تلك الثقافة هي التي تحدد تطلعاتنا فلن تكون هناك إصلاحات حقيقية في النظام العربي، وسوف تكون كل المبادرات التي تخرج من عباءة المثقفين والداعية للإصلاح مجرد ذر الرماد في العيون.
الإصلاح الحقيقي لكل مناحي حياتنا، يبدأ من التأسيس لثقافة منطلقة من القرآن تجعل الهدف الأساس إقامة القسط بين الناس، والعدالة في الحكم، وقد يلاقي هذا الأمر بعض الصعوبات حتى من قبل الناس الذين ألفوا العبودية وتكيفوا مع الاستبداد ويرون أن الخروج على المألوف في الحكم هو خروج عن الدين وقيم التراث كما نلاحظ ذلك حتى من قبل بعض النخب المثقفة التي ترى في الديمقراطية والحرية مخالفة للأسس الدينية التي ألفوها في كيفية أنظمة الحكم، وهي إشكالية قديمة، تعرض لها رواد الإصلاح والتغيير في تاريخنا الإسلامي، كما حدث لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، حيث تشبعت نفوس الناس في عهده بثقافة الاستبداد وكان من الصعب عليها أن تألف نظاماً جديداً يقوم على العدل، ولذا لاقى الإمام علي
، حيث تشبعت نفوس الناس في عهده بثقافة الاستبداد وكان من الصعب عليها أن تألف نظاماً جديداً يقوم على العدل، ولذا لاقى الإمام علي صعوبات عديدة في ذلك حيث يقول
صعوبات عديدة في ذلك حيث يقول : أيّتها النفوس المختلفة، والقلوب المتشتّتة، الشاهدة أبدانُهم، والغائبة عنهم عقولهم، أظأركم«أعطفكم» علي الحقّ وأنتم تنفرون عنه نفور المعزي من وعوعة الأسد ! هيهات أن أطلع بكم سَرارَ العدل، أو اُقيم اعوجاجَ الحقّ.
: أيّتها النفوس المختلفة، والقلوب المتشتّتة، الشاهدة أبدانُهم، والغائبة عنهم عقولهم، أظأركم«أعطفكم» علي الحقّ وأنتم تنفرون عنه نفور المعزي من وعوعة الأسد ! هيهات أن أطلع بكم سَرارَ العدل، أو اُقيم اعوجاجَ الحقّ.
اللهمّ إنّك تعلم أنّه لم يكن الذي كان منّا منافسةً في سلطان، ولا التماس شىء من فضول الحطام، ولكن لنَرِدَ المعالم من دينك، ونُظهر الإصلاح في بلادك ; فيأمن المظلومون من عبادك، وتُقام المعطّلة من حدودك.
بخلاف مدرسة الخلفاء، كانت مدرسة أهل البيت تؤمن أن العدل يمثل أصلاً ليس عقيدياً فحسب، بل في كل الممارسات الأخرى، ففي العبادة يشترط فقهاء مدرسة أهل البيت
تؤمن أن العدل يمثل أصلاً ليس عقيدياً فحسب، بل في كل الممارسات الأخرى، ففي العبادة يشترط فقهاء مدرسة أهل البيت العدل في إمام الجماعة، فلا تصح العبادة خلف الفاجر أو الفاسق، بينما المدرسة السلطانية لا تشترط العدالة فتصح العبادة خلف الإمام الفاجر«صلوا خلف البر والفاجر»، وهكذا تتأسس الكثير من المناشط وفق قاعدة القبول بالظلم، أما مدرسة أهل البيت
العدل في إمام الجماعة، فلا تصح العبادة خلف الفاجر أو الفاسق، بينما المدرسة السلطانية لا تشترط العدالة فتصح العبادة خلف الإمام الفاجر«صلوا خلف البر والفاجر»، وهكذا تتأسس الكثير من المناشط وفق قاعدة القبول بالظلم، أما مدرسة أهل البيت ، فتجعل أهم شرط الحكومة «الإمامة العامة» والإمامة في الصلاة هي العدالة، وتفقد النظم السياسية الشرعية عندما تفقد العدالة، وتُفقد مشروعية الإتمام في العبادة عند فقد العدالة كذلك، من هنا يتأسس المجتمع الإسلامي في النظرة القرآنية وفي مدرسة أهل البيت
، فتجعل أهم شرط الحكومة «الإمامة العامة» والإمامة في الصلاة هي العدالة، وتفقد النظم السياسية الشرعية عندما تفقد العدالة، وتُفقد مشروعية الإتمام في العبادة عند فقد العدالة كذلك، من هنا يتأسس المجتمع الإسلامي في النظرة القرآنية وفي مدرسة أهل البيت من خلال إقامة العدل والقسط، ولا يمكن أن ينجح المشروع النهضوي للأمة إلا من خلال نشر ثقافة حقيقة تجعل الاستبداد والظلم قيماً سلبية يجب القضاء عليها ونبذها من حياتنا، وليكن رائدنا كتاب الله العزيز حيث يقول : يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون..
من خلال إقامة العدل والقسط، ولا يمكن أن ينجح المشروع النهضوي للأمة إلا من خلال نشر ثقافة حقيقة تجعل الاستبداد والظلم قيماً سلبية يجب القضاء عليها ونبذها من حياتنا، وليكن رائدنا كتاب الله العزيز حيث يقول : يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون..