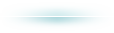حصاد التواصل مع متشددي السلفية (*)
أكثر من سبع سنوات مضت على انطلاق "مشروع" التواصل المفرط في النعومة بين الشيعة والسلفية في السعودية. هذا المشروع كان منذ ساعاته الأولى مثار جدل كبير تركز حول مشروعيته وجدواه وثمنه ومنهجيته المناسبة التي تحفظ للجميع حقوقهم وكرامتهم وعقيدتهم. وبعد مرور هذه الفترة الطويلة نسبيًا من الزمن يحق لنا كمجتمع أن نبدي بعض ملاحظاتنا عليه خصوصًا وأن البعض أدخله في إطار مقدس منزهًا إياه عن الانتقاد الصريح بحجة أو بأخرى، ولذلك سأركز على نقد هذا المشروع من النواحي المذكورة آنفا. يحق لنا أن نتساءل عن حصاد هذا المشروع لأن سنواته لم تمر بدون ثمن، بل دفعنا فيها ثمنًا غاليًا عبر إضعاف ورقتنا الإعلامية الرابحة وهي التمييز ضد المواطنين الشيعة بإضفاء الطابع التسامحي لمن هو مستمر في التمييز –كما سيتبين لاحقًا-، وعبر تضييع الجزء الأكبر من الفرصة السياسية التاريخية التي لم يبق منها إلا الفتات والذي سيأتي عليه الزمن أيضًا ما لم يُصحَح المنهج الذي ساهم في هذه الخسارة.
لا شك ولا ريب أن التواصل مع الآخر هو أمر مطلوب في أصله، فالآيات القرآنية وسيرة رسولنا الأكرم والأئمة من أهل بيته
والأئمة من أهل بيته مليئة بفصوله العظيمة، ولكن هل يكون التواصل إلا "لغايات" محددة، أم هو "هدف مطلق" يجب تحقيقه بأي وسيلة كانت؟ هل يصح التواصل بطرق تضر بمصالحنا الكبرى؟ هل هو خاضع لحسابات لا ينبغي تعديها أو الإضرار بها؟
مليئة بفصوله العظيمة، ولكن هل يكون التواصل إلا "لغايات" محددة، أم هو "هدف مطلق" يجب تحقيقه بأي وسيلة كانت؟ هل يصح التواصل بطرق تضر بمصالحنا الكبرى؟ هل هو خاضع لحسابات لا ينبغي تعديها أو الإضرار بها؟
من البديهي أن التواصل ما هو إلا وسيلة لتحقيق المصالح التي يُجرى من أجلها وإلا فإنه يكون عبثيًا اعتباطيًا، ولذلك نبدي هنا بعض الملاحظات على طريقة التواصل الحالي مع السلفية وعلى أداء المساهمين فيه انطلاقًا من هذا المبدأ:
أولاً: سعي المساهمين في هذا المشروع لإظهاره بأنه من المفاتيح الرئيسية للتخلص من التمييز والاحتقان الطائفي، وإخفائهم عن الناس حقيقة يعرفونها حق المعرفة ألا وهي أن التواصل مع السلفية ليس من مفاتيح الحل، لأن المشكلة لم تنتج أصلا عن حالة القطيعة بل حدث العكس من ذلك تمامًا، فهل ننجح في إخماد النار عندما ننشغل بالدخان ونتعامى عن وقودها المستمر في التدفق؟
لا حل لأزمة التمييز إلا بقرار "حكومي شجاع" وهو ما يجب أن تتوجه جهودنا لاستحصاله، لأنه -وكما يبدو- لن يأتي كمكرمة، وليس الحل بتبادل المجاملات مع "مواطنين" آخرين. فهل هذه المبالغة في أهمية التواصل هي للتغطية على الفشل في تحقيق إنجاز جوهري عبر التواصل مع الجهات الرسمية؟
ثانيا: تحول التواصل –وربما من غير قصد- إلى "مكياج" إعلامي لتجميل صورة أصحاب المواقف الطائفية التي لم تخف حدتها حتى مع التواصل، وتصويرهم أو تمكينهم من تصوير أنفسهم للداخل والخارج بأنهم أشخاص معتدلون ومتسامحون يتواصلون مع الآخر في مشروع "وطني" انفتاحي.
كان يهرول البعض خلف أي طُعم يلقيه هؤلاء الطائفيون دون صدور أي مؤشر على تخليهم عن مواقفهم الطائفية المنافية للاعتدال، فيحدث التواصل فيحصلون على الأوسمة الإعلامية وسرعان ما ينقلبون على أعقابهم ويتحفونا بمواقف لا تقل طائفية عن مواقفهم السابقة بعد أن يحصلوا على مبتغاهم، ويعود المهرولون بخُفَّي حنين.
فهل هناك إضرار بالقضية أكثر من تصوير الطائفي بأنه متسامح رغم إصراره على التمييز والطائفية، أو مساعدته على تصوير نفسه كذلك بمنحه الفرصة الذهبية؟ ألا ينبغي اشتراط تخليهم المسبق عن المواقف الطائفية ليكونوا أهلاً لهذه الفرصة؟ هل يلدغ المؤمن من جحر مرتين؟ وهل تكريم القاضيين الطائفيين في القطيف أشد جرمًا من إعطاء هؤلاء فرصًا إعلامية لا متناهية لتجميل صورتهم وترميم سمعتهم؟
ثالثا: وقوع المساهمين في التواصل الناعم في "فخ الابتزاز"، حيث تقوم الأطراف الأخرى بالضغط عليهم للحصول على مواقف وبيانات سياسية و دينية وفتاوى يهرع هؤلاء إلى إصدارها فور صدور الطلب، ويتبرعون بها أحياناً دون طلب من أحد -مع تسببها في إدانة وتقييد الشيعة وخلق بلبلة وشقاق وسط البيت الشيعي- طمعًا في نيل رضا الأطراف الأخرى ومنعًا لإحراجهم بها، رغم أنه لا يحق للآخر المطالبة بها في أغلب الأحيان لأنها تدخل في باب حرية المعتقد تارة و لكونها خارجة عن واجبات المواطن تارة أخرى.
فهل هذا التواصل هو للحصول على الحقوق، أم لتلبية طلبات تعتبر في حد ذاتها تعديًا على حقوق المواطن؟؟
رابعا: قد يقول قائل: أليس التمييز الطائفي ناتجًا عن حالة الإقصاء؟ ألا تزول حالة الإقصاء بالتواصل والتعرف على الآخر؟
إن التواصل الذي يمكنه أن يعالج التمييز الطائفي هو التواصل المبني على الاعتراف بالآخر واحترامه والنظر له نظرة الند للند، بالإضافة إلى مصارحة الآخر بواقع الأمور مصارحة لا تحول دونها المجاملة الزائدة عن حدود اللباقة وحسن الخلق. منهج التواصل الحالي يفتقد جميع هذه الشروط في أغلب حالاته حتى الآن. فأغلب الشخصيات السلفية المشاركة في هذا المشروع ما زالت تشكك في وطنية الشيعة، كما أنها لا تصرح بإسلام الشيعة الإثني عشرية بل تجاهر بأنهم مخالفون في الأصول كالتوحيد، وفي ضروريات الدين كالقرآن، وكلتا الحالتين تقتضيان خروج صاحبهما من الملة وهو ما يفقده درجة المواطنة الكاملة حسب "التطبيق" السلفي للإسلام. هذه الشخصيات كانت تحوّل كل فرصة للتواصل المبني على أسس المواطنة والأخوّة في الدين –كما هو مفروض- إلى محكمة عقائدية ومحكمة إثبات ولاء يكون الشيعي فيهما المتهم الذي تكال له نفس التهم البالية في كل مرة، وهذه التهم لا يجوز إسقاطها عنه مهما قدم من أدلة وبراهين. هذا لأن تواصلهم جاء أصلا لإقناع المتهم بجرمه لعل العقوبة تخفف عنه، أو لتصيد أدلة ضده وليس للتعايش معه أو تفهُّمِه.
وعليه فهل التواصل بصورته الحالية يؤمَّل منه حل مشكلة التمييز ضد الشيعة؟ وهل هو إنجاز "في طريق نيلهم لحقوقهم"، أم هو تواصل مع الأشخاص الخطأ بالطريقة الخطأ؟
ومع افتراض أنه ناجح، فهل يصح أن يتحول هذا التواصل لشغل شاغل للنخبة السياسية ويُصوَّر بأنه مشروع رئيسي للطائفة، أم يحال على اللجان الاجتماعية والثقافية وتتفرغ النخبة السياسية للعمل في الجانب السياسي لتحقيق الأهداف ؟
خامسا: إذا كان التواصل مع شخصيات متطرفة هو مقدمة لإيصال قضيتنا إليهم، فهل توجد أي إنجازات "جدية" في هذا المجال؟
قد يعتبر بعضنا تعاطف بعض السلفيين مع ما قلَّ ونَدَر من قضايانا إنجازًا لهذا التواصل، ولكن على هؤلاء أن يركزوا على كلمة "جدية" آنفة الذكر. فحتى وإن اعتبرنا –جدلا- بأن هذا هو إنجاز فإنه لا يغير شيئا في معادلة التمييز الطائفي، لأنه -وبكل بساطة- تلك الشخصيات التي تعاطفت حتى الآن ليس لها وزن يعتد به إلا في نطاق ضيق ولا تأثير واسع لها في الطرف الآخر، هذا إن تغاضينا عن حقيقة أن أغلب هذه الشخصيات هي شخصيات معتدلة أصلا ولا مشكلة لنا معها حتى قبل التواصل. هذا في ظل استمرار جميع الرموز الطائفية الكبيرة المشاركة في مشروع التواصل في مواصلة التمييز ضد الشيعة وتشويه صورتهم ومنها الشيخ سلمان العودة، الشيخ عبد الله المنيع، وأخيرًا الشيخ سعد البريك، وبالتالي فأين يكمن الإنجاز العظيم؟ وأين يكمن تفوق هذا المشروع؟
ألا تشير هذه النقاط إلى أن هناك خللا مَّا في هذا المشروع؟ ألا يستدعي مرور 7 سنوات إجراء مراجعة جريئة -على الأقل- على منهجية وثمن التواصل الناعم؟ هل نستمر في الجري في الظلام؟ ولماذا؟
ما كان هذا المقال إلا محاولة لتسليط الضوء على خلل جلي -لا يتعامى عنه إلا مكابر- يدفع المواطنون الشيعة ضريبته بضياع فرصتهم السياسية التاريخية في استحصال بعض حقوقهم، وبتجميل صورة ظالميهم، وبإهدار ما بقي من كرامتهم في سبيلٍ يُصوَّر لهم بأنه خطوة مهمة في طريق خلاصهم رغم عدم وجود مؤشرات "ملموسة وحقيقية".
إننا لم نعد نشتري وعودًا وهمية وشعارات ممتصةٍ لغضب الشارع وانتظارًا أبديًّا يميت القضية، بل نريد مصارحة شفافة للغاية من قبل أصحاب هذه الشعارات والوعود –مهما علا شأنهم- حفاظاً على ما بقي من مصداقيتهم، فما كان مقبولاً بالأمس لم يعد مقبولا اليوم.