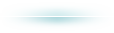ومضات من أرض التضحيات
عندما نعود بذاكرة كربلاء للسنة 61 هجرية / 681 ميلادية، سنعود عبر نافذة واحدة لا غير، هي ثقافتنا الراسخة في أذهاننا. تلك الثقافة ستكون هي المحدد الحقيقي لوعينا و نضجنا. و بالطبع فإن أهم محددات تلك الثقافة هي الحجب التي تصنعها الثقافة بيننا و بين وعينا و ترسخها بيننا و بين نضجنا، و التي تبنيها بيننا و بين العرفان. و تلك هي الخطوط الحمراء التي تشكل هالة مقدسة تتجاذب أطراف تفكيرنا لتنحرف بها في متاهات لا متناهية، فتحل التوهمات في مسيرة التفكير محل انكشاف المعارف و كشف الحق.
من أجل هذا كان على العارف أن يتجاوز تلك الحجب، و أن يطرح ركام ثقافة المجتمع و الموروث المسبب لها، و أن يتخطى الكثرات، ليذوب بعدها في الوحدة الحقيقية، فيحرر الأسئلة لديه من تجليات ثقافة المجتمع و مؤثرات الكثرة و الأحبة و مصالح الذات، ليغدوا التساؤل لديه منطلقا دون قيد أو شرط. عندها فقط يمكن أن نبدأ الإبحار في بحور كربلاء، بالضبط في تلك اللحظة التي نستطيع فيها أن نطرح أسئلة حقيقية دون قيد أو شرط متجاوزين كل قداسة و كل عرف ... حيث في محضر الله لا مقدس إلا الله. عندها فقط يمكن أن نعبر الحجب عندما نتخلص من تلك الشروط التي تتوهمها أدمغة المتعبدين في الغفلة لأصنام تصنعها أيدي البشر.
و في هذا المقال أود أن أطرح بعض التساؤلات الحرة، التي قد تتمكن من الإبحار بنا نحو كربلاء حقيقية. (كربلاء) لم تصنعها تحريفات المصالح الفردية ولا الاجتماعية. و لم تصغها ثقافة مجتمع، لتغيظ بها ثقافة مجتمع آخر. فكربلاء حقا هي تلك الحادثة التاريخية التي كلما جئناها بسؤال حقيقي قدمت لنا جوابا حقيقيا، كما أننا كلما جئناها بسؤال مزيف قدمت لنا جوابا مزيفا أيضا، فهكذا هو التراث و هكذا هو أثر الثقافة في التراث، ذلك الأثر الذي لن يحيد عنه الدهر أبدا.
لقد صنعت (ثقافة) من الحسين  إماما معصوما، و رجل كرامات، و رجل زهد، و رجلا رأى الموت أحلى من القلادة على جيد الفتاة فتقلده، في قصة شاء الله أن يخلدها في عنق التاريخ. فعاش بها الحسين و توهج و تجدد كما عاش بها الدهر و تجدد. كما صنعت (ثقافة أخرى) من الحسين إغواء و فتنة و خارجيا خرج على إمام الزمان (يزيد) فحق عليه أن تبدد أعضاؤه و أن تسبى نساؤه و أن يقتل هو و أهله و صحبه و من معه عطاشى في حر أرض تسمى كربلاء، دون أن تصله شفقة و لا رحمة من أحد. في هذه الثقافة: (الحسين) خارجي، خرج على دين جده و ملك (يزيد)، فقتل بسيف جده و جيش (يزيد). هكذا تفعل الثقافة دائما بامتلاكها القدرة على التغيير و التبديل و قلب الأمور، فتستدل منطقيا و تضع في عقولنا ما تقول.
إماما معصوما، و رجل كرامات، و رجل زهد، و رجلا رأى الموت أحلى من القلادة على جيد الفتاة فتقلده، في قصة شاء الله أن يخلدها في عنق التاريخ. فعاش بها الحسين و توهج و تجدد كما عاش بها الدهر و تجدد. كما صنعت (ثقافة أخرى) من الحسين إغواء و فتنة و خارجيا خرج على إمام الزمان (يزيد) فحق عليه أن تبدد أعضاؤه و أن تسبى نساؤه و أن يقتل هو و أهله و صحبه و من معه عطاشى في حر أرض تسمى كربلاء، دون أن تصله شفقة و لا رحمة من أحد. في هذه الثقافة: (الحسين) خارجي، خرج على دين جده و ملك (يزيد)، فقتل بسيف جده و جيش (يزيد). هكذا تفعل الثقافة دائما بامتلاكها القدرة على التغيير و التبديل و قلب الأمور، فتستدل منطقيا و تضع في عقولنا ما تقول.
لقد تحولت كربلاء في أيدينا إلى حبر على ورق، و بالثقافة يمكن لهذا الحبر أن يفعل في عقولنا ما يشاء، كما أن عقولنا و قلوبنا المضاءة بنور الوعي الذي يقذفه الله في قلب من يشاء يمكنها أن تفعل بتلك الواقعة أيضا ما نشاء، فتصل للحق عندما تتحرر من ظلمة الحجب و أسرها، فتنطلق لتحلق بأسئلتنا خارج سرب ثقافة الموروث المفروض بالكثرة و الأنا و إملاءات المصالح التي تهب علينا من هنا أو هناك.
هنا دعونا نقف إذا وقفات تأمل من أجل الحق في مسرح كربلاء، نسمح فيها للأسئلة أن تتحرر من أسر ذواتنا، و أسر ثقافتنا، و أسر مجتمعاتنا، و أسر مصالحنا الخاصة الفردية و الاجتماعية المفروضة على الواقعة. فرب حق أقصته الشهوات، و رب باطل أدناه الطمع و تراكم الأهواء.
- أولا: مسرحية الحسين، أم مسرحيتنا نحن و نضال الحسين:
تقول (ثقافة) موروثة أن الحسين  خرج لكربلاء قاصدا الموت، و أخرج النساء قاصدا الموت، و أرسل مسلم بن عقيل قاصدا الموت، و خرج على يزيد قاصدا الموت، و خرج بالنساء قاصدا الموت، و أخرج الرضيع قاصدا الموت، و استلم كتب أهل الكوفة قاصدا الموت ... فهل يعقل أن يكون الحسين
خرج لكربلاء قاصدا الموت، و أخرج النساء قاصدا الموت، و أرسل مسلم بن عقيل قاصدا الموت، و خرج على يزيد قاصدا الموت، و خرج بالنساء قاصدا الموت، و أخرج الرضيع قاصدا الموت، و استلم كتب أهل الكوفة قاصدا الموت ... فهل يعقل أن يكون الحسين  قد خدع كل هؤلاء؟؟؟!! ... فكان كل هذا السياق التاريخي ترتيبا مسرحيا لمسرحية أسميناها فيما بعد مسرحية (التضحية و الفداء)؟؟!!. هل حقا كانت مسرحية؟؟ و طقوسا عبادية فقط لا غير؟؟ أم أن الحسين
قد خدع كل هؤلاء؟؟؟!! ... فكان كل هذا السياق التاريخي ترتيبا مسرحيا لمسرحية أسميناها فيما بعد مسرحية (التضحية و الفداء)؟؟!!. هل حقا كانت مسرحية؟؟ و طقوسا عبادية فقط لا غير؟؟ أم أن الحسين  كان أكبر من كل ذلك بكثير؟؟!! ... و أهدافه أعظم مما صورته لنا ثقافة تريد أن تخرج الحسين
كان أكبر من كل ذلك بكثير؟؟!! ... و أهدافه أعظم مما صورته لنا ثقافة تريد أن تخرج الحسين  من سياق الجهاد و النضال الطبيعي و المنطقي ضد الظلم و الجور و الطغيان؟؟؟!!!.
من سياق الجهاد و النضال الطبيعي و المنطقي ضد الظلم و الجور و الطغيان؟؟؟!!!.
- ثانيا: جيش الحسين و دولة الحسين، أم جيش الناس و دولة الناس؟
خرج مع الحسين  من مكة المكرمة ثلاثة آلاف يزيدون أو يقلون كما تذكر المصادر التاريخية، ثم خذله أكثر هؤلاء الأتباع، فلم يبق معه إلا قليلون صمدوا فضحوا و استشهدوا في كربلاء. و كانت الأطماع طبعا كما يبدوا سبب خروج هؤلاء الأتباع الذين خذلوه
من مكة المكرمة ثلاثة آلاف يزيدون أو يقلون كما تذكر المصادر التاريخية، ثم خذله أكثر هؤلاء الأتباع، فلم يبق معه إلا قليلون صمدوا فضحوا و استشهدوا في كربلاء. و كانت الأطماع طبعا كما يبدوا سبب خروج هؤلاء الأتباع الذين خذلوه  . وهنا يجب أن تثور في نفوسنا عدة تساؤلات: فهل خرج الحسين
. وهنا يجب أن تثور في نفوسنا عدة تساؤلات: فهل خرج الحسين  للإصلاح و إقامة حكم، أم خرج للقتل و القتال و تقديم قربان دماء بين يدي الله لا غير. إذا كان هذا الخروج قد كان لإقامة حكم و لإصلاح وضع فاسد فيصح أن نسأل أنفسنا كيف يصطحب الحسين
للإصلاح و إقامة حكم، أم خرج للقتل و القتال و تقديم قربان دماء بين يدي الله لا غير. إذا كان هذا الخروج قد كان لإقامة حكم و لإصلاح وضع فاسد فيصح أن نسأل أنفسنا كيف يصطحب الحسين  معه هؤلاء الأتباع من أصحاب الأطماع و الأهواء الذين لا يستقيم معهم حكم، كما لا يستقيم معهم أيضا قتال. و إذا كان الحسين
معه هؤلاء الأتباع من أصحاب الأطماع و الأهواء الذين لا يستقيم معهم حكم، كما لا يستقيم معهم أيضا قتال. و إذا كان الحسين  قد قصد الموت، فلم غش كل هؤلاء باستدراجهم معه في ركب جيشه و ركاب أمانيهم و أطماعهم و تطلعاتهم و أهوائهم؟؟؟!!.
قد قصد الموت، فلم غش كل هؤلاء باستدراجهم معه في ركب جيشه و ركاب أمانيهم و أطماعهم و تطلعاتهم و أهوائهم؟؟؟!!.
إن من يقرأ خط سير الحسين  من المدينة مرورا بمكة وصولا لأرض كربلاء، و يتمعن خطبه
من المدينة مرورا بمكة وصولا لأرض كربلاء، و يتمعن خطبه  جيدا، و يقرأ خط سير الأحداث، و يقرأ هذا التاريخ المليء بالمتعارضات قراءة واعية بعد أن يزيح عن قلبه حجب الظلمات و حجب النور، سيجد الحسين
جيدا، و يقرأ خط سير الأحداث، و يقرأ هذا التاريخ المليء بالمتعارضات قراءة واعية بعد أن يزيح عن قلبه حجب الظلمات و حجب النور، سيجد الحسين  قد سار في ركاب الواقعية، فتعامل مع الواقع كما هو، و تحرك سياسيا وفق معطيات العصر و الزمان و الإمكانات. و لو قامت للحسين
قد سار في ركاب الواقعية، فتعامل مع الواقع كما هو، و تحرك سياسيا وفق معطيات العصر و الزمان و الإمكانات. و لو قامت للحسين  دولة أو ولاية لكانت دولة واقعية، دولة الناس و ولاية الناس، يؤسسها جيش الناس، و لن تخلوا من أخطاء الناس و تجارب الناس و نواقص الناس، التي سيتعامل معها الحسين
دولة أو ولاية لكانت دولة واقعية، دولة الناس و ولاية الناس، يؤسسها جيش الناس، و لن تخلوا من أخطاء الناس و تجارب الناس و نواقص الناس، التي سيتعامل معها الحسين  بواقعية و نزاهة و إخلاص واقعي أيضا. و هذا في فهمي هو خط الأئمة و خط المهدي (عج) أيضا في دولته الموعودة، كما كانت دولة الإمام علي
بواقعية و نزاهة و إخلاص واقعي أيضا. و هذا في فهمي هو خط الأئمة و خط المهدي (عج) أيضا في دولته الموعودة، كما كانت دولة الإمام علي  أيضا من قبل، فهي دول تقوم فوق أكتاف الرجال البشر (لا الملائكة ولا الشياطين)، و يقودها الأئمة بتقواهم و إخلاص.
أيضا من قبل، فهي دول تقوم فوق أكتاف الرجال البشر (لا الملائكة ولا الشياطين)، و يقودها الأئمة بتقواهم و إخلاص.
- ثالثا: لا تغرنكم الرايات و لا الشعارات:
من مواعظ كربلاء أيضا، التي ينبغي الالتفات لها و استيعابها جيدا بوعي تام، عدم الانخداع بالشعارات و الرايات و التقسيمات و التصنيفات، فكثير ممن صنفوا مع الحسين  باديء الأمر قد خذلوه ساعة المعركة. كما أن كثيرا ممن بايعوه هم من قاتلوه. بينما نصره آخرون كانوا خارج راية الحسين
باديء الأمر قد خذلوه ساعة المعركة. كما أن كثيرا ممن بايعوه هم من قاتلوه. بينما نصره آخرون كانوا خارج راية الحسين  ، بل تحت راية الأعداء. و هكذا كان الإمام علي
، بل تحت راية الأعداء. و هكذا كان الإمام علي  حين خذله قراء القرآن فكانت الخديعة باسم الله و باسم القرآن. فالإنسان الصالح و الإنسان المسلم لا يعرف حقيقة بالرايات و لا بالشعارات و لا بالتصنيف أو التقسيم الديني أو المذهبي. لأن هذه الشعارات و هذه الرايات إنما هي قشور و الله وحده أعلم بما تحتها. فرب كافر أو مسيحي أو يهودي بحسب الظاهر، هو في الحقيقة أقرب للإسلام كثيرا من رافعي الشعارات الناسين للمضامين. فأولئك لن تكشف حقيقتهم إلا المعارك الحقيقية بين الحق و الباطل. لذا ينبغي التركيز أكثر على المواقف الحقيقية و الأفعال الواقعية التي تجسد العدل و الحق و الإيمان، أو الظلم و الباطل و الكفر و الطغيان، لا التصنيفات و التقسيمات الدينية أو المذهبية التي لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه.
حين خذله قراء القرآن فكانت الخديعة باسم الله و باسم القرآن. فالإنسان الصالح و الإنسان المسلم لا يعرف حقيقة بالرايات و لا بالشعارات و لا بالتصنيف أو التقسيم الديني أو المذهبي. لأن هذه الشعارات و هذه الرايات إنما هي قشور و الله وحده أعلم بما تحتها. فرب كافر أو مسيحي أو يهودي بحسب الظاهر، هو في الحقيقة أقرب للإسلام كثيرا من رافعي الشعارات الناسين للمضامين. فأولئك لن تكشف حقيقتهم إلا المعارك الحقيقية بين الحق و الباطل. لذا ينبغي التركيز أكثر على المواقف الحقيقية و الأفعال الواقعية التي تجسد العدل و الحق و الإيمان، أو الظلم و الباطل و الكفر و الطغيان، لا التصنيفات و التقسيمات الدينية أو المذهبية التي لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه.