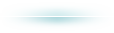دعوا المزايدات تفلحوا
هل القرآن الكريم مخلوق؟ أم أزلي؟
كان هذا سؤالاً من الأسئلة العبثية التي شغلت الأمة الإسلامية، ولم تقف المسألة عند إحراز إجابة علمية عن السؤال المطروح -الذي كان ظاهره الإيمان، وباطنه الدهاء- بل تجاوزت كل الحدود، وتطايرت إثر السؤال/المصيبة، رؤوسٌ خالفت إرادة السيَّاف. فمن طرح السؤال، لم يشأ الوصول لقول فصل، أو إحداث حراكٍ فكريٍّ في الأمة، وإنما أراد تصفية بعض الخصوم بلبوس الإيمان!
وللقارئ أن يعيش الدهشة والحيرة وهو يقرأ كلامًا قاله أحمد بن حنبل، فيما يخص المسألة، يقول -أبعدنا الله وإياكم عن منطقه-: "والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، فمن زعم أنّ القرآن مخلوق فهو جَهْمِي كافر، ومن زعم أنّ القرآن كلام الله عزّ وجلّ ووقف ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق، فهو أخبث من الأوّل. ومن زعم أنّ ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة، والقرآن كلام الله، فهو جهمي. ومن لم يُكَفِّر هؤلاء القوم كلّهم فهو مثلهم" !
والمعتزلة تقول: "إنّ القول بكون القرآن غير مخلوق أو قديم شرك بالله سبحانه" !
هكذا وصلت الحال بالمسلمين، ولم يسلم منهم، حتى من امتنع عن الاصطفاف إلى جهة ما، مكتفيًا بالقول: إن القرآن الكريم، كتاب الله، وكفى!
وقد أصاب (أمل دنقل) كبد الحقيقة، حين قال:
"لا تسألني إن كان القرآن
مخلوقًا أو أزليّ
بل سلني إن كان السلطان
لصًّا.. أو نصف نبيّ".
وقد تتكرر القضية في الأمة بعناوين أخرى. ومجتمعنا المحلي ليس بعيدًا عن هذه الحالة، فقد شهدنا مؤخرًا تجاذبًا فيما يخص التواصل والحوار مع الآخر المذهبي، وأثار أحد المثقفين، سؤالاً سطحيًّا مفاده: هل التواصل مع السنة يعد وسيلة أم مشروعًا؟! -كما طُرِحَ السؤال مجددًا من قبل السيد منير الخباز في ندوة له- وشُغِلنا، بمناقشة هذه الجزئية التي لا تغني ولا تسمن من جوع!
وكما يقال: لا مشاحة في الألفاظ.. فإذا قلنا بأن التواصل وسيلة لا مشروع، فلا مشكلة في ذلك! إذ إن المهم في الأمر أن نعمل ونتحرك؛ لخدمة الطائفة –حسب تعبير الأحبة- لا أن نركن في المجالس والبيوت أو خلف الكيبورد، ونقلل من عمل الآخرين أو نعيبه؛ لنبرر بذلك تقاعسنا وكسلنا وغيابنا عن الساحة.. كما إن دور القائلين بأن التواصل مجرد وسيلة، لا يتجاوز أيضًا؛ إلقاء المحاضرات والدروس وإقامة الندوات ونشر بعض المطبوعات! وهذه الأخرى، تُعد وسائل تقليدية، والكل يمارسها بدرجات متفاوتة.. أليس كذلك؟
ولا يخفى أن بعض العاملين لدينا في الساحة، ذواتهم متضخمة إلى درجة الانفجار، لذا تجدهم يجنحون للمبالغة في الحديث عن الأعمال الاعتيادية التي تخرج من تحت عباءاتهم، وكأنها الفتح العظيم! ومنطق بهذا التعالي، لا يصح أن يكون لغة يعتادها المؤمنون! والأدهى حين نجد البعض منهم، يدخل ضمن قائمة الذين ﴿يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا﴾[آل عمران:188]!
من المعيب حقًّا، أن أمتدح سلوكًا صدر مني، ثم أعيبه في وقت لاحق، لأنه صدر من آخرين، والأمثلة على ذلك كثيرة. ولعلّنا نجد في الممارسة الحقوقية للناشطين، وبعض المثقفين المتفيقهين، مصداقًا يكشف هذا المسلك. ففي يوم من الأيام نستدعي النصوص التي تأمر بالتواصل مع السلطان بهدف خدمة المؤمنين! ثم نستدعي مرة أخرى نصوصًا تعارضها، لتأكيد مسلك المتقين، الذين يفرون من أسوار السلاطين! تُسَوَّقُ علينا هذه المقولات، بذرائع واهية! والجماهير المخدوعة، تُحسِن التصفيق للمزايدين.
أعمالنا تتكئ على حالة من الارتجال، وإن أحسنا الظن، فهي قائمة على تفكير وتخطيط فردي أو جهوي! ونطالب الآخرين أن يتحركوا بناءً على دراسات تفصيلية! ونطلب منهم أن يتيحوها للجماهير أيضًا، لتطبيق مبدأ الشفافية!! وكأن المنظرين، قد أغرقوا الساحة بالعمل المبني على دراسات ميدانية!! والخشية أن تكون أعمالنا وأعمالهم ﴿كسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾[النور:39].
بعض المتفيقهين لا يفرقون بين العمل الإصلاحي المبدئي، وبين العمل الربحي المصلحي! لذا تجدهم يشغلون أنفسهم بعمل مقارنة عبثية، فيقول بعضهم بسذاجة: في الشركات يسأل المدير عن خطته القائمة على دراسات ميدانية، ويطلب منه تحديد الفترة الزمنية التي يحتاجها لتحقيق أهداف المشروع! ويريد هؤلاء تطبيق الأسلوب نفسه على العمل الإصلاحي، وكأنهم في فصل دراسي بمعهد أو كلية أكاديمية!
لا يصح أن نمارس دور المتفرِّج الذي يُحاسب الآخرين من برجه العاجي، ليوِّزع على من يشاء منهم صكوك المغفرة والرحمة، ويمنعها عمّن يشاء! فالمجتمع ليس مغفلاً، ليقبل منطق ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾[المائد:24].
ولمن يطرح مقولة المحاسبة، أقول: إن شئت أن تحاسب الآخرين، فحاسب نفسك أولاً، وإن شئت انتقادهم؛ فانتقد نفسك أولاً.
أحبتي.. الصراخ ليس بديلاً عن العمل! فماذا صنعت أنت لمجتمعك؟ وماذا قدّمت لطائفتك؟ وما هي أهدافك لذلك؟ ومتى ستحققها؟ وكيف؟ أسئلة، آمل أن يجيب عنها المتفرجون! الذين استحوذ عليهم الشيطان؛ فأنساهم قيمة المحبة. لذا تراهم يعيشون في حالة عداء وقطيعة مع الآخرين، لأسباب أقل ما يقال حيالها: إنها أسباب تافهة!
فهل يعقل أن نعادي المؤمنين لأنهم آمنوا بخيارات عملية لم نرتضيها؟
وهل نرى في أنفسنا حالة من العصمة؛ لنعيش وَهْمَ امتلاك الحقيقة المطلقة؟ لنشطب بعد ذلك كل من خالفنا من قائمة الإيمان! وهل تفكير كهذا يقترب من فكر أهل البيت (صلوات الله عليهم أجمعين)، ونحن ندعي أننا نسير على نهجهم، ونقتدي بهداهم؟!
عجيب ومحيِّرٌ أمر البعض منّا! فبعضنا يكيل السباب والشتائم لنهج وسلوك حركة طالبان -التي أهلكت الحرث والنسل في أفغانستان، وأينما وصلت أيديها الآثمة- بذريعة أنها حركة تكفيرية أحادية الرؤية، لا ترى أبعد من أرنبة أنفها، فهي تزعم أنها الإسلام كلُّه وغيرها الكفر! وماذا عنّا؟ ألا يوجد بيننا من يقول أنا الحق! وغيري الباطل؟!
ألا يوجد بيننا من يُنصِّب نفسه فرعونَ صغيرًا، وإن لم يقل لنا بلسانه: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الأَعْلَى ﴾[النازعات:24]؟
ألا يوجد بيننا من يريد إرغام الآخرين على خياراته بمنطق: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾[غافر:29]؟
لا أدري متى سنتخلّص من هذه الأمراض، ونحن على يقين بأن "الله لم يجعل لأنبيائه العظام، حق جبر الناس على الدين... فكيف يأتي رجل لا يعرف من الدين شيئًا كثيرًا لينصب نفسه حاكمًا على الدين، ويشهر من الدين سلاحًا ضد كل من خالف آراءه أو حتى لو خالف مصالحه الشخصية التي سرعان ما يجعلها دينًا"؟ .
وفي الختام أقول: آمل أن نخدم مجتمعنا بعيدًا عن العناوين الفضفاضة، أو لغة المزايدة على خدمة الطائفة والمذهب؟ فالكلُّ، يدعي وصلاً بليلى، ووحده -سبحانه وتعالى- العالم، بمن هو أهدى سبيلاً.